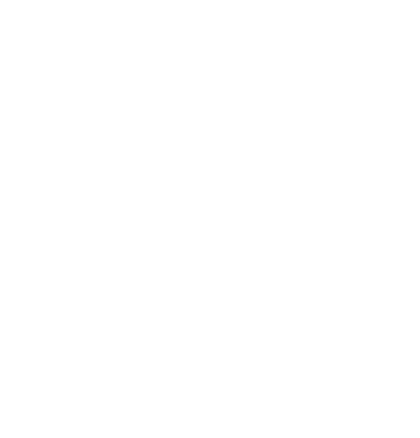إن مفهوم الجيش الصغير القوي يعني تزويد القوات المسلحة بأجيال حديثة من الأسلحة، والمعدات، تؤمِّن خفة الحركة، والحشد النيراني المكثف، ودقة الإصابة، مع القدرة على نقل المعلومات وتبادلها بين القوات في الميدان، أو بين القوات ومراكز القيادة، مما يسمح بتنفيذ المهام بعدد محدود من القوات، ومجابهة قوات متفوقة عددياً، وتقليص الحاجة إلى حشود كبيرة من المقاتلين، يتم الزج بهم في ميدان القتال، أو الانتقال بفيالق وفرق من ميدان قتال إلى آخر.
 وفكرة هذا المفهوم تدعو للاعتماد على تقنية المعلومات المتقدمة، لتمكين القوات من التحديد الدقيق للأهداف، ورصدها، ومتابعتها، وإصابتها من مسافات بعيدة وآمنة. والقوة العسكرية المطلوبة لتنفيذ هذه المهام، تكون صغيرة العدد، وسريعة الحركة، وتم تدريبها وتأهيلها جيداً، ولا تضطر لخوض المعارك المباشرة مع العدو، إلا حين تقتضي الضرورة ذلك.
وفكرة هذا المفهوم تدعو للاعتماد على تقنية المعلومات المتقدمة، لتمكين القوات من التحديد الدقيق للأهداف، ورصدها، ومتابعتها، وإصابتها من مسافات بعيدة وآمنة. والقوة العسكرية المطلوبة لتنفيذ هذه المهام، تكون صغيرة العدد، وسريعة الحركة، وتم تدريبها وتأهيلها جيداً، ولا تضطر لخوض المعارك المباشرة مع العدو، إلا حين تقتضي الضرورة ذلك.
ويرتكز مفهوم الجيش الصغير القوي على تقليص دور القوات البرية لصالح القوات الجوية، التي يكون لها دور رئيسي، حيث يتم امتلاك سلاح جو متطور تقنياً، وله القدرة على تنفيذ ضربات وقائية واستباقية على الأهداف الحساسة للعدو، لإفقاده عوامل تفوقه في الساعات الأولى للمعركة من خلال تدمير مراكز القيادة والسيطرة، وذلك بامتلاك أسلحة جوية هجومية، عالية الدقة، بعيدة المدى، لها مقدرة كبيرة على اختراق الدفاع الجوي المعادي وشل فعاليته، والوصول لأهدافها، علاوة على امتلاك مجموعة متنوعة من أنظمة الحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسب والاستخبارات (C4I)، ومقذوفات تناسب المهام المطلوبة، إضافة الى تدريب متطور للقادة والقوات، على جميع المستويات.
وفي الحرب البرية، حفزت التهديدات العابرة للحدود والصراعات الدائرة في العديد من مناطق العالم الدافع لتحديث أسلحة القوات البرية، سعياً وراء أنظمة أكثر كفاءة من النماذج التي أتاحت الحروب السابقة الفرصة لاختبار قدراتها، ونتج عن ذلك تحول جوهري لصالح صناعة الأسلحة البرية لتلبية الحاجة إلى هذا التطوير الكيفي. ويسمح الحجم الصغير للقوات البرية بتغطية فعالة من أنظمة الدفاع الجوي لحمايتها، سواء تلك الأنظمة قصيرة المدى، أو متوسطة المدى. ويركز مفهوم الجيش الصغير القوي على القوات الخاصة، بشكل كبير، وإمدادها بأحدث التجهيزات، علاوة على قدرة توصيلها خلف خطوط العدو.
وفي الحرب البحرية، يتم التركيز على امتلاك قطع بحرية صاروخية سريعة، وصغيرة الحجم، يصعب كشفها بالمستشعرات المختلفة، وزيادة مدى النيران، ونشر أنظمة دفاع ساحلي، صاروخية ومدفعية، بعيدة المدى. وعلى سبيل المثال، فإن الصاروخ K-300P Bastion-P هو نظام دفاعي صاروخي ساحلي روسي يعرف لدى حلف الناتو بالرمز SSC-5، وتم تصميمه للتعامل والتصدي لمختلف أنواع سفن السطح، ويمكنه العمل في ظروف تشويش وإعاقة إلكترونية مكثفة، ويعتمد النظام على صواريخ P-800 Oniks بالنسبة للنسخة الروسية، وصواريخ P-800 Yakhont بالنسبة للنسخ التصديرية التي يصل مداها حتى 300 كم، وتصل سرعتها حتى 2.6 ماخ. ويتطلب هذا النوع من القوات، البرية، والجوية، والبحرية، تنسيقاً بين كل الأسلحة، في إطار ما ما يعرف بـ«معركة الأسلحة المشتركة»، وأجهزة استخبارية فعالة، تضمن وصول المعلومات عن تحركات ونوايا العدو، والتغيرات التي يجريها في قواته.
وتاريخياً، فإنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أجريت العديد من الدراسات لتقييم الأسلحة التي استخدمت في هذه الحرب، ونتج عن ذلك مفهوم الجيش الصغير القوي، الذي تبناه عدد من القادة، مثل شارل ديجول في فرنسا، وليدل هارت في بريطانيا، وسيكت في ألمانيا، ودعوا إلى بناء جيوش صغيرة الحجم، ولكنها قوية التأثير بفضل نوعية السلاح، وخاصة الآليات المدرعة، لقدرتها على اختراق الدفاعات والتحصينات المعادية، ولتمتعها بخفة الحركة، وقوة النيران، وتوفير الحماية للطاقم. ولكن، كان هناك من الخبراء العسكريين من يرى أن هذا المفهوم يقلل من دور الجندي، وأن الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) أكدت الدور الرئيسي للمقاتل في أي حرب، لأنه القادر على استخدام الآلة.
دور التقدم التقني
إن امتلاك أي طرف للتقنيات العسكرية المتقدمة يستدعي قيام الخصم بتطوير تقنيات مضادة. وعلى سبيل المثال، فإنه مع دخول الغواصات للحرب البحرية، تم تطوير الألغام البحرية التـي تزرع على أعماق بعيدة. ومع استخدام الآليات المدرعة، طورت المقذوفات المضادة لها لاختراق دروعها. ومع ظهور الطيران في سماء المعارك طورت أنظمة الدفاع الجوي، المدفعية والصاروخية، الثابتة والمتحركة. ومع تطوير الرادار في الحرب العالمية الثانية، واستخدامه في كشف الأهداف الجوية وتتبعها، ظهرت الصواريخ المضادة للاشعاع الراداري، وكان أول استخدام لها في حرب فيتنام. ومع تطور الصواريخ البالستية، طورت أنظمة الدفاع الصاروخي لمواجهتها، على المديات المختلفة. ومع التوسع في استخدام الطائرات المسيرة للاستطلاع والتدمير، كما يجري حالياً بين روسيا وأوكرانيا، يتم تطوير أنظمة قادرة على رصدها وتدميرها، بالرغم من صغر حجمها، مقارنة بالمنصات الجوية الأخرى. وكل هذا يعني أن تطوير التقنيات يستدعي تطوير تقنيات مضادة، وأن مجرد امتلاك هذه التقنيات وتوظيفها في ميدان المعركة لا يضمن النصر، بل يؤكد أهمية التدريب، ورفع كفاءة العنصر البشري، على كافة المستويات.
وتطورت أسلحة القتال، وزادت كثافة التشكيلات، مع المرونة في توزيعها على مسرح العمليات، وجرت المساعي لتوفير الحماية للقوة البشرية، من خلال الدروع الفردية، ثم البدلة الحديدية الكاملة، في ظل اتساع نطاق عتاد التقدم والالتحام. وبظهور البارود، بدأ عصر جديد، تسود فيه الأسلحة النارية، بمختلف أنواعها، وتم تطوير وسائل نقل المواد المتفجرة، سواء براً، بواسطة المدفعية والصواريخ، أو جواً، بواسطة الطائرات المختلفة، أو بحراً، بواسطة السفن والغواصات. أي أن إمكانات ووسائل التدمير ظلت كما هي، بينما تركز التطوير التقني في وسائل الحمل والنقل، ولذا جرى الاهتمام بتقنية توجيه المقذوفات لزيادة الدقة، فكان هنك التوجيه الراداري، والتلفزيزني، والحراري، والليزري، ثم التوجيه بواسطة الأقمار الاصطناعية. وخلال الحرب العالمية الثانية، تم القاء 9000 قنبلة زنة 2000 رطل بواسطة 1500 طلعة للطائرات القاذفة الثقيلة الأمريكية B-17 التي طورت في ثلاثينيات القرن الماضي، لتدمير الأهداف في مساحة 60×60 ياردة مربعة. وفي عام 1970، وخلال حرب فيتنام، تم إلقاء 176 قنبلة من نفس الطراز بواسطة 88 طلعة للقاذفة – المقاتلة الاعتراضية F-4 Phantom II لنفس الغرض. وفي أواخر عام 1991، وخلال عمليات عاصفة الصحراء، لم يكن يلزم لذلك سوى قنبلتين موجهتين ليزرياً، تطلقان من طائرة هجوم أرضي أمريكية واحدة طراز F-117 Nighthawk (أحيلت هذه الطائرة الى التقاعد في أبريل عام 2008).
ومع بداية القرن الحادي والعشرين، حدث تطور هائل في مجال الحواسب الإلكترونية، فأصبحت تتميز بقدرات عالية على معالجات البيانات، وظهرت أنظمة التسليح المتكاملة، الفائقة الدقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحاولت قوات التحالف الدولي اختبار بعض هذه الأنظمة خلال حرب تحرير الكويت في عام 1991 بشن حملة جوية لمدة 39 يوماً، تميزت بالتوسع في استخدام الطائرات المسيرة Drones، والتي أنجزت مئات المهام المتنوعة، فضلاً عن ارتفاع دقة الإصابة، فكانت الحملة البرية بدون خسائر بشرية تذكر في قوات التحالف. وفي البوسنة، استخدم الأمريكيون نظام «جستارز» Joint Surveillance Target Attack Radar System – JSTARS لمراقبة مسرح العمليات البرية من الجو، حيث يمكنه التقاط مكان وطراز أي نوع من أنواع الآليات التي تتحرك على الأرض، في مساحة 200 كيلومتر مربع، على شاشة واحدة، وفي مختلف الظروف الجوية.
وتم إنتاج صواريخ وطائرات مسيرة، يتم توجيهها آلياً، من خلال النظام الكوني لتحديد المواقع GPS على سطح الكرة الأرضية، وبما يضمن توجيه ضربات نيرانية قوية للأهداف المعادية، وبدقة عالية، ومن مسافات بعيدة. ويضاف إلى ذلك تطوير أنظمة مستشعرات لتجميع ومعالجة البيانات، في مكان واحد، وفي الوقت الحقيقي، مما يؤدي إلى زيادة فعالية دائرة العمل المتكاملة (المعلومات – القرار – الفعل) لتتاح للقوات المحاربة سرعة الأداء، والمحافظة على المبادأة، والكفاءة في إدارة الأعمال القتالية. وعمليات صنع واتخاذ القرار ستتغير هي أيضاً، وستشتمل هذه القرارات على خليط من «الذكاء الاصطناعي» والإنساني، وستكون هذه العمليات أقل تسلسلاً، وأكثر فورية.
 مجالات التفوق
مجالات التفوق
إن الثورة في التقنية العسكرية تدور حول تحقيق التفوق في ثلاثة مجالات:
1 - تجميع المعلومات، حيث إن المستشعرات المحمولة جواً وفضائياً، يمكنها التقاط كل شىء يتحرك في منطقة محددة، براً وبحراً وجواً، وفي مختلف الظروف الجوية.
2 - معالجة المعلومات التي يتم تجميعها، وذلك من خلال أنظمة متقدمة للقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات، والتي تفسر المعلومات التي تتلقاها من مراكز الاستشعار، وتعرضها على الشاشات، ثم تقوم تلك الأنظمة بتكليف منصات الأسلحة بالقيام بمهامها. وتوزيع المعلومات الخاصة بالقوات الصديقة والمعادية على كل المستويات القيادية. وفي هذا الإطار، تسعى القوات المسلحة الأمريكية إلى إيجاد نظام متكامل يوحّد المعلومات بين أسلحة القوات كافة، حيثما تكون، وبشكل لحظي، كما ترغب بالانتقال إلى مرحلة الاتصال عبر شبكة الإنترنت، بحيث تتيح لكل فرد في الميدان الحصول على أي معلومات يريدها مباشرة.
3 - استخدام كل تلك المعلومات في القيام بقصف الأهداف، بعيدة المدى، ولكن بدرجة عالية من الدقة، فالصواريخ الجوالة Cruise، على سبيل المثال، الموجهة بالأقمار الاصطناعية، يمكنها إصابة هدف على بعد مئات الأميال. وعلى سبيل المثال، فإنه في التاسع عشر من مارس 2022، أعلن وزير الدفاع الروسي أن قواته استخدمت أحدث صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة في أوكرانيا لتدمير موقع لتخزين الأسلحة في غرب البلاد، وهذا الصاروخ جو/أرض طراز «كينجال» Kh-47M2 Kinzhal (الخنجر) وهو صاروخ باليستي يطلق من الجو، تم تصنيعه لتسليح المقاتلة الاعتراضية بعيدة المدى MiG-31K المحدثة. ووفقاً للجيش الروسي، فإن هذا الصاروخ قادر على ضرب أهداف على مسافات تزيد على 2000 كم، بسرعة تصل إلى 10 ماخ، ومثل هذه السرعة تجعل أي نظام دفاع صاروخي حديث عديم الفائدة.
وبالرغم من كل ما سبق، فإن الخبرة التاريخية تؤكد أن التقنية لا تضمن التفوق العسكري، وإن عززت من إدارة العمليات. ففي العصور القديمة، استطاعت النار الإغريقية أن تصد هجمات «البرابرة» لحين، إلا أنها لم تستطع إيقاف زحفهم. وفي العصور الوسطى، تغلب فرسان السهول على تحصينات المدن الكبرى في شرق أوروبا، والعراق، والصين، وفارس. وفي العصر الحديث، قليل ما انتصرت القوات الأكثر تقدماً في مجال التقنية العسكرية على تلك الأقل تقدماً، لأسباب متعددة، ومثال ذلك الحرب في فيتنام، وفي أفغانستان. فتقنية المعلومات تعزز التوجهات نحو تحقيق الكفاءة واستخدام الأسلحة على نحو يتصف بحسن التمييز، وقلة الخسائر، ولكن ثمة خطر في المبالغة في الفارق الذي يمكن للمعلومات أن تحدثه بمفردها، فهي لا تستطيع أن ترفع الروح المعنوية في القوات، أو أن تدمرها، أو تحميها، أو تحركها، لكنها تستطيع أن توفر دعماً حيوياً لهذه القوات.
منظومة جديدة لتسليح الجيش الصغير القوي
إن أنظمة التسليح التي تستطيع إصابة العمق في أراضي العدو، والتي تسمح باستخدام التقنيات الحديثة من أجل تحقيق السيطرة على مسارح العمليات، ستصبح من أهم عناصر تسليح الجيش الصغير القوي. وأنظمة المدفعية طويلة المدى ذات الذخائر «الذكية»، والراجمات الصاروخية، والطائرات المسيرة المستخدمة في التدمير والإستطلاع، وقوات الإبرار الجوي القادرة على خوض قتال في أماكن بعيدة، وكذلك القوات الخاصة، تمنح الجيش الصغير قدرة حقيقية على خوض المعارك العميقة. ويدعم تلاحم نيران هذه الأسلحة المجهود الحربي من أجل تحقيق تفوق نسبي في القوات للالتحام النيراني المباشر مع القوات المعادية.
والصواريخ الموجهة الحديثة أصبحت عالية الدقة إلى حد أن كل جانب يسعى إلى أن تكون له الضربة الأولى لمنع العدو من القيام بالرد. وفي نفس الوقت، ستتسع العمليات العسكرية جغرافياً أيضاً، بينما يقل عدد القوات والآليات المستخدمة فيها. وبما أن الدفاعات ضد الصواريخ ليست سهلة، وليست متاحة للكثير من الجيوش، فإن الأهداف الحيوية، مثل الموانئ والقواعد الجوية، وأي مواقع ثابتة، ستكون معرضة للضرب.
مستويات جديدة للتدريب والتعليم
من أجل الوفاء بجميع المهام المطلوبة، فإن الجيش الصغير القوي في حاجة إلى قادة يتمتعون بمهارات قيادية، ويكونون مرنين، ومبدعين، وقادرين على التأقلم مع ظروف المعركة، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم. ولذلك، فإن تدريب القادة هو العنصر الأساسي في الخطط الهادفة إلى رفع مستويات التدريب. والتقدم التقني في أنظمة التسليح يستدعي استيعاب المقاتلين لهذه التقنية، وتمكينهم من استخدامها إلى الحد الأقصى. وبدون التفكير في هذه الأمور مسبقاً، وبدون التخطيط الجيد، فإنه يتم تطبيق التدريب في الوقت الخطأ، أو من قبل المسؤولين غير المناسبين، أو حتى في المرحلة الخطأ عند استخدام أسلحة جديدة. وتتعزز فاعلية التدريب عند القيام بتطبيقه بشكل تدريجي، أو القيام به في الوقت المناسب. ومنظومة التدريب العسكري الحديثة تعتمد على التدريب باستخدام تقنيات الحرب الافتراضية (المحاكيات)، والمباريات الحربية لتدريب القادة وهيئات الأركان، إضافة إلى إجراء المناورات، بمستوياتها المختلفة، والتدريب المشترك مع القوات الصديقة.
تساؤلات مشروعة
لا يستطيع أحد التنبؤ بالمستوى الذي ستنتهي إليه هذه الثورة التقنية العسكرية، ولكن يمكن وضع عدد من التساؤلات، مثل:
كيف ستؤثر هذه الثورة في الأسلوب الذي ستحارب به الجيوش، وفي تنظيمها؟
هل ستؤدي هذه الثورة إلى تغيير في كيفية إدارة الصراعات ذات الكثافة المنخفضة، مثل حرب العصابات، والحرب داخل المناطق الآهلة، والحرب غير المتكافئة؟
ما مدى سهولة مقاومة هذه التقنيات بتقنيات مضادة؟
وهل تضمن هذه التقنيات النصر لمن يتملكها، ويتقن استخدامها؟ أم أنها مجرد مضاعف للقوة؟
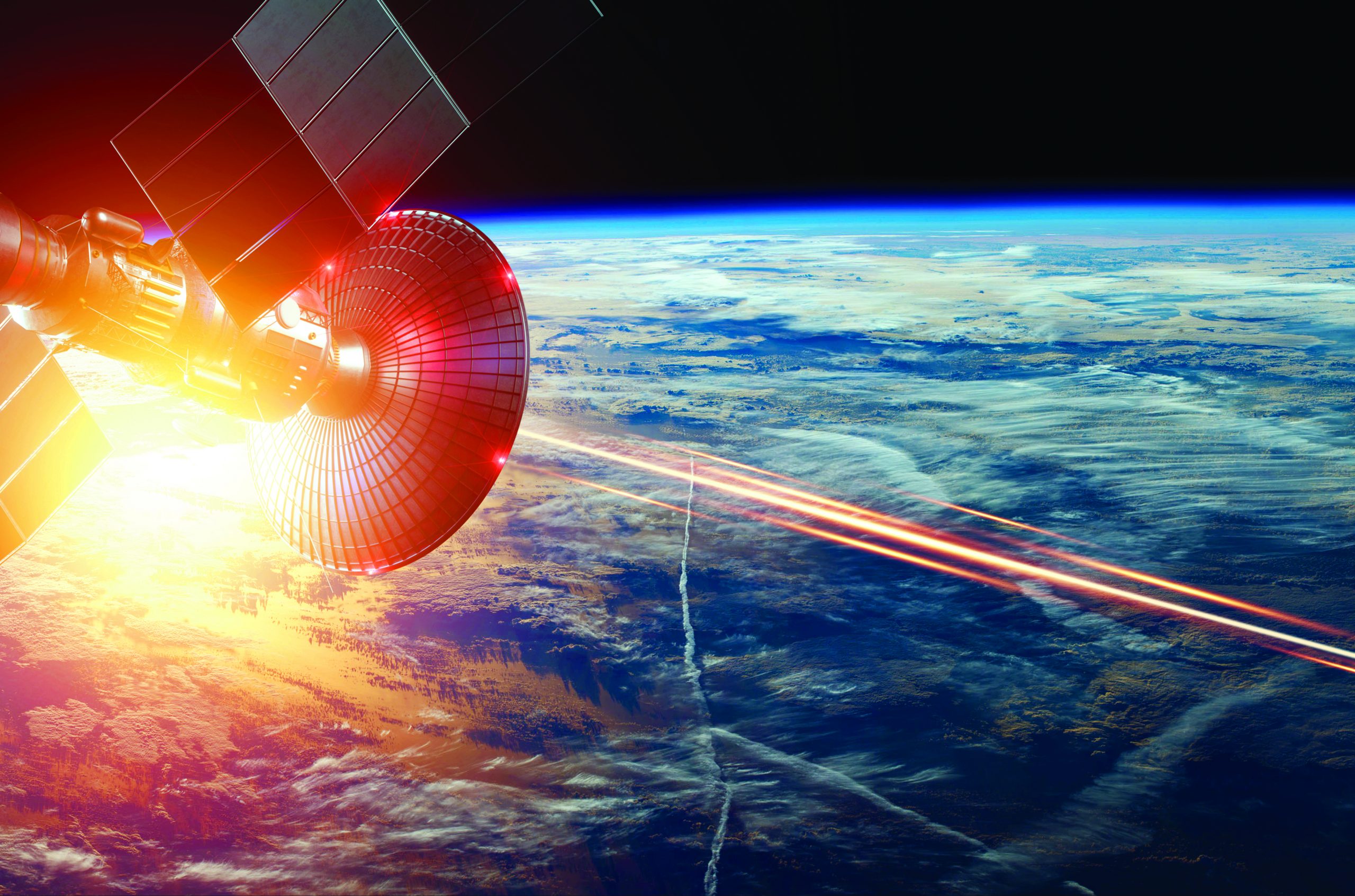
تغيرات جذرية للتطبيق
يتطلب تطبيق مفهوم الجيش الصغير القوي تغييرات جذرية في شؤون الأمن والدفاع، وفق منظومة من المحددات والاعتبارات، أساسها تخفيض حجم الجيش، كماً وتنظيماً، لجعله أصغر حجماً، وأكثر كفاءة، بما يتيح الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية المتاحة، وبما يساعد على زيادة قدرة توفير الاحتياجات التسليحية، واستيعاب أحدث التطورات التقنية في الأسلحة، وذلك من خلال الآتي:
التخلي عن الخدمة العسكرية العامة إلى نظام يعتمد – بدرجة كبيرة – على المتطوعين الذين يشجعون بحوافز مالية، ولفترة خدمة أطول. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ألغت 17 دولة أوروبية التجنيد الإلزامي. وبالنسبة للجندي العادي، تشتمل خدمته على فترة تدريب أساسي تتلوها فترة احتياط. أما ذوو المهن الحرفية، الذين ينتظر أن تزداد أعدادهم باطراد، فتشملهم عقود خدمة لفترة طويلة، وتكون قابلة للتجديد.
وضع معايير لانتقاء القادة وضباط الأركان من خلال التركيز على النوعية والحرفية في كل المجالات.
الاستعداد للدفاع بجيش عامل صغير العدد، لديه قدرات إنذار مبكر، وقوة جوية، وأسطول، ونظام تعبئة، ونظام نقل فعال للاحتياطي.
تطوير منظومات القيادة والسيطرة والاستطلاع والاستخبارات، بما يمكِّن القادة من الحصول على صورة واقعية وموحدة لما يجري في مسرح العمليات، بحيث تساعد هذه المنظومات على اتخاذ قرارات سليمة، وتخصيص مهام قتال فورية صحيحة للوحدات.
دعم قوة الردع التقليدية من خلال امتلاك الصواريخ البالستية، والصواريخ الجوالة «كروز»، وتسليح الغواصات والسفن بصواريخ تطلق على أهداف برية من مسافات بعيدة.
تطوير أساليب التدريب والتأهيل للقادة والضباط من مختلف المستويات، بما يجعلهم قادرين على مواجهة المشاكل المعقدة والطارئة في الميدان.
تعميق وتوسيع نطاق التحالفات الإستراتيجية مع قوى كبرى، وخاصة في مجالات التعاون العسكري المختلفة.
تكثيف دور القوات الجوية لتكون قادرة على القيام بإنجازات مؤثرة.
تحديات حرب المدن
ساد التعويل على القدرة التقنية، وخفة العمليات العسكرية، وسرعتها، بعض أوساط القيادات العسكرية العليا في العديد من الدول طوال العقدين الماضيين، وأطلقت هذه القيادات خططاً ترمي إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة لتخفيض أعداد منتسبيها، وتزويدها بأحدث الأسلحة، على أساس أن القوة الضاربة في الحرب الحديثة جوية، أكثر منها برية، وأن هذه الحرب لا تحتاج إلى حشد جيوش هائلة على الأرض، بمقدار ما تقتضي سيطرة كاملة على الجو. فالأساس فيها قوات أقل عدداً، وتقنية أكثر تقدماً، قوات خفيفة الحركة، سريعة الانتشار، عالية التسليح، جيدة التدريب، ذات قدرة عالية على المناورة والالتفاف والاختراق، اعتماداً على منظومة إلكترونية متقدمة، تتيح لها أن تعمل كشبكة متناغمة الأداء.
ولكن ثبت أن حرب المدن تعتبر العائق الأكبر أمام هذه الخطط. فعلى الرغم من التطور الكبير الذي تم في جمع ومعالجة وتحليل واستخدام المعلومات، ما زالت المدن قادرة على تضليل التخطيط العسكري المعتمد فقط على ذلك، حيث أن الشوارع المعقدة، وشبكات الطرق المتداخلة، والطبوغرافية السكانية، تحرم القادة في مراكز القيادة البعيدة من رؤية الأمور بشكل أفضل.
ويمكن اعتبار حرب المدن نموذجاً عصرياً لحرب العصابات، حيث تستخدم فيها المقذوفات المضادة للدروع والمضادة للطائرات، والعمليات الانتحارية، والمتفجرات بدائية الصنع، والكمائن، ويقدم الخصم على استخدام مزيج من الأسلحة التقليدية والتكتيكات غير النظامية، ومهاجمة المدنيين، أو شن هجمات انتحارية، والتصرف الإجرامي من أجل تحقيق أهدافه. وبالتالي، فإن هذه الحرب تدمج مجموعة من أنماط القتال المختلفة، والتكتيكات، والتشكيلات غير المنظمة، للاستفادة من كل أشكال القتال، وتسعى الجماعات المسلحة لاستنزاف خصومها وإرهاقهم لإرغامهم على الانسحاب من أراضٍ معينة.
وتنطوي حرب المدن على تحديات وتكاليف يمكن أن تفوق الحرب التقليدية بكثير، حيث تضعف الفعالية المتفوقة للأسلحة والاتصالات. ولذلك أصبحت المدن ساحات القتال المستقبلي، والحرب فيها تطرح تحديات خاصة أمام القوات النظامية المتفوقة تقنياً التي تواجه جماعات مسلحة. وفي الوقت الذي تخفض فيه حرب المدن بشدة من فاعلية الأسلحة والمستشعرات المتطورة، فإنها تشكل بيئة ملائمة للأسلحة الأقل تطوراً، ولتكتيك حرب العصابات، حيث تشكل المباني أماكن لاختباء المدافعين من المهاجمين لإطلاق النار عليهم.
الخلاصة
يعتمد مفهوم الجيش الصغير القوي على أن طبيعة الحروب في المستقبل سوف تتغير بشكل كبير، حيث ستغيب تلك الجيوش الجرارة، وستصبح الجيوش أكثر ميلاً إلى تقليص القوة العددية، وزيادة الكفاءة، مع الاستفادة مما توصلت اليه تقنية صناعات الأسلحة. أي أن جيش المستقبل سيكون هو الجيش الصغير القوي، الذي يعتمد على الكيف بدلاً من الكم، وهذا يعني أنه سوف يكون قادراً على مضاعفة تواجده وقوته، بالرغم من أنه سوف يلغي تواجده العسكري المباشر في قواعد ثابتة، وسيكون ذلك نتيجة للتطور التقني في مجال المعلومات والاتصالات، مما سيمكنه من إلغاء دور «التواجد المكاني»، بحيث يكون الاعتماد على الأساليب المتطورة في القتال، والتي تعتمد على أن يكون الجيش أقوى، وأفضل، وأقل تكلفة.
» لواء د./ علي محمد علي رجب
)باحث عسكري وخبير استراتيجي)