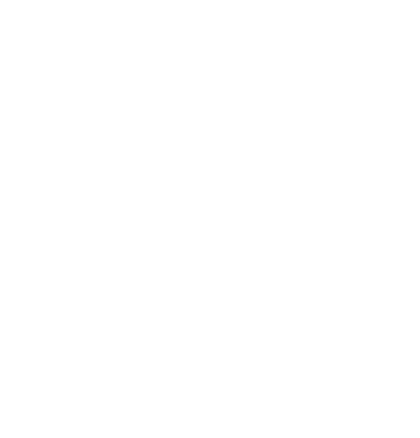لم تكد تصدر استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، في ديسمبر 2025، حتى واجهت سيلاً من الانتقادات من جانب عدد كبير من المحللين الأمريكيين، إلى جانب الانتقاد الأوروبي الرسمي لها، وذلك على أسس عدة، أبرزها أنها تمثل قطيعة مع السياسة الأمريكية السابقة، وعدولاً عن النظام القائم على القواعد، الذي أرسته الإدارات الأمريكية المتعاقبة وصولاً إلى الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، باتجاه نظام مغاير قائم على «الصفقات»، غير أن المتمعن في قراءة الاستراتيجية يكشف عن أنها تعبّر عن تيار قوي داخل الولايات المتحدة، وتمثل انتقالاً من مبادئ «الهيمنة الليبرالية» إلى قواعد المدرسة الواقعية لتعترف بصعود القوى الكبرى، وأن الاستراتيجية المثلى للولايات المتحدة تتمثل في تبني سياسات «توازن القوى» في اعتراف واضح بأن النظام الدولي بات نظاماً متعدد الأقطاب.

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استراتيجية جديدة للأمن القومي، في 5 ديسمبر 2025، والتي تعكس أولويات الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وتعيد رسم سياسة الولايات المتحدة تجاه أقاليم العالم المختلفة، وبالتالي ستترك تأثيراً مباشراً على الترتيبات الأمنية فيها. فقد ركزت الاستراتيجية على عدة مبادئ ذات صلة، منها نقل العبء الأمني إلى الحلفاء، ورفض مبدأ الهيمنة على العالم، وتركيز الحضور العسكري الأمريكي على نصف الكرة الغربي، في إعادة إحياء لمبدأ مونرو، وإن بصيغة معدلة. وسوف يكون من المفيد إلقاء الضوء على أبعاد الاستراتيجية، وانعكاساتها على منافسات القوى الكبرى، وعلى الاستقرار في أقاليم العالم المختلفة. ومن أجل فهم هذه الاستراتيجية وارتداداتها الإقليمية والدولية، سوف يتم شرح السياق المصاحب لها، وأبرز المبادئ الحاكمة للانخراط العسكري الأمريكي حول العالم، وكذلك علاقاتها بالقوى الكبرى الأخرى، لاسيما روسيا والصين، وارتدادات الاستراتيجية على أقاليم العالم المختلفة. وقبل الشروع في توضيح النقاط السابقة، سوف يتم الإشارة أولاً إلى أهمية الاستراتيجية الكبرى في سياسات القوى العظمى.
أولاً: أهداف الاستراتيجية عبر التاريخ
تاريخياً كان ينظر إلى الاستراتيجية على إنها العلم المعني بدراسة كيفية الانتصار في الحروب، غير أنه وكما لاحظ، إدوارد ميد إيرل، خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الاستراتيجية عنصراً رئيسياً لفن إدارة الدولة في كل الأوقات، إذ أنه على مدار التاريخ، صاغت الدول استراتيجيات وطبقتها لمنافسة خصومها في وقت السلم، كما في أثينا وأسبرطة في القرن الثالث قبل الميلاد، وفرنسا وبريطانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وألمانيا والمملكة المتحدة في القرنين التاسع عشر والعشرين، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في القرنين التاسع عشر والعشرين، ثم الولايات المتحدة واليابان خلال النصف الأول من القرن العشرين، ثم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وفي حين أن بعض الصراعات، مثل التنافس البريطاني – الأمريكي قد انتهى بشكل سلمي، فإن التنافس البريطاني – الألماني أدى، في النهاية، إلى اندلاع الحرب بين لندن وبرلين. أما التنافس الأمريكي – السوفييتي، فقد ولّد صراعات بالوكالة حول العالم وسلام بارد. وتعرّف الاستراتيجية الكبرى على إنها «التنسيق بين أدوات قوة الدولة لتحقيق أهداف سياسية»، أما الاستراتيجية العسكرية، فهي توظف القوة العسكرية لخدمة الاستراتيجية الكبرى. وتتوقف درجة نجاح الاستراتيجية على قدرة الدولة على تحديد هدف سياسي واضح، والقدرة على تقييم الميزة النسبية مقارنة بالعدو، وحساب التكلفة والعائد بدقة، وكذلك تحليل المخاطر والفوائد المحتملة الناتجة عن تبني استراتيجيات بديلة.
لذلك أشارت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة على مجموعة من الأسئلة في البداية، والتي يتوجب الإجابة عليها، وهي:
ماذا تريد الولايات المتحدة (الأهداف)؟
ما هي الأدوات المتاحة لتحقيق ما تريده؟
كيف يمكن ربط الغايات والوسائل في إطار استراتيجية أمن قومي ناجحة (الطرق)؟
وتوحي هذه الأسئلة بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تحديد أهداف واضحة ومحددة، وليس واسعة، ولذلك عرّفت الاستراتيجية السياسة الخارجية على إنها «حماية المصالح الوطنية الجوهرية»، وأن هذا هو مناط التركيز الوحيد للوثيقة، في مؤشر ضمني على تخلي واشنطن عن السعي وراء أهداف واسعة مثل الدفاع عن القيم الديمقراطية، أو إدامة الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي. ويمكن القول إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وضعت هدفاً واضحاً، وهو الحفاظ على التفوق الأمريكي، إذ أكد ترامب في بداية الاستراتيجية أن «هذه الوثيقة هي خريطة لضمان أن أمريكا سوف تظل الأعظم والأنجح في تاريخ البشرية»، مضيفاً أنه في «في السنوات المقبلة، ستواصل واشنطن تطوير كل جانب من جوانب قوتها الوطنية – وسنجعل أمريكا أكثر أمناً، وأكثر ثراءً، وأكثر حريةً، وأعظم شأناً، وأكثر قوةً من أي وقت مضى». وإذا كان ما سبق، يمثل الغاية أو الهدف الرئيس لواشنطن، فإن طريقة تحقيقها، تتمثل ليس من خلال السعي لتحقيق الهيمنة على النظام الدولي، ولكن من خلال توازن القوى. وتمثل هذه النقطة تحديداً في الاستراتيجية الجديدة «قطيعة مع الماضي»، خاصة الاستراتيجية الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.
أما فيما يتعلق بالأدوات، فتتمثل في تعزيز كافة أدوات القوة الأمريكية، مع التركيز بشكل أساسي على القوة العسكرية، لردع الخصوم، ومنع اندلاع الحرب حول تايوان، على سبيل المثال، والقوة الاقتصادية لتأكيد جاذبية الولايات المتحدة باعتبارها شريك لدول العالم في مواجهة القوى الأخرى المناوئة، خاصة الصين، والقوة الدبلوماسية من خلال إحلال السلام حول العالم، بما في ذلك من خلال الوساطة بين روسيا وأوروبا للتوصل لتسوية للحرب الروسية – الأوكرانية. كما لا تغفل الاستراتيجية القوة الناعمة الأمريكية، وكذلك الأداة الاستخباراتية، إذ سوف يقع على عاتق مجتمع الاستخبارات الأمريكي مسؤولية رقابة سلاسل الإمداد الرئيسية ومجالات التقدم التكنولوجي حول العالم لضمان قدرة الولايات المتحدة على فهم التهديدات والمخاطر لأمن الولايات المتحدة وازدهارها. وبالتالي، فإن الاستراتيجية الجديدة تعلي من توظيف أدوات القوة جميعها بهدف واحد، وهي تجنب التورط في حروب جديدة تشغل واشنطن عن منافسة الصين.
ثانياً: التخلص من الافتراضات الخاطئة
رأت إدارة الرئيس ترامب أن هناك افتراضان خاطئان تبنته الإدارات السابقة، الأمر الذي أدى إلى أخطاء جسيمة في السياسة الأمريكية. أشارت الاستراتيجية صراحة إلى أحد هذين الافتراضين، والذي ساد على مدار ثلاث عقود، وهو أن «فتح الأسواق الأمريكية أمام الصين، وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فيها، ونقل الصناعات الأمريكية إليها، سيُسهِّل دخول الصين إلى ما يُسمى «النظام الدولي القائم على القواعد». أكدت الاستراتيجية خطأ هذا الافتراض، إذ أصبحت الصين غنية وقوية، واستعملت ثروتها وقوتها لتحقيق مكاسب كبيرة. وأكدت الاستراتيجية أن النخب الأمريكية، عبر أربع إدارات متعاقبة من كلا الحزبين السياسيين، كانت إما شركاء متواطئين في استراتيجية الصين، أو في حالة إنكار».
أما الافتراض الأخر، وهو الذي لم تسطره الإدارة الأمريكية صراحة في استراتيجيتها، ويرتبط بالإدارة الأمريكية السابقة أكثر من غيرها، وهي أنه يمكن الانتصار في حرب سريعة ضد روسيا عبر دعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً. دأب ترامب على مهاجمة هذا الافتراض في تصريحاته المختلفة في غير مرة، إذ أكد أن هذه الحرب هي حرب بايدن، وأن هذه الحرب لم تكن لتحدث لو كان رئيساً للولايات المتحدة، وأن هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها.
أدى الافتراض الضمني السابق إلى تبني واشنطن موقفاً مغايراً من موسكو، إذ لم تعد الأولى تنظر إلى الأخيرة باعتبارها تهديداً، بل نصبت الولايات المتحدة نفسها باعتبارها وسيطاً في الصراع بين موسكو وأوروبا، إذ نصت الاستراتيجية إلى «أن الولايات المتحدة سوف تقوم بانخراط دبلوماسي كبير لوضع شروط الاستقرار الاستراتيجي في الأراضي الأوراسية إلى جانب تقليل مخاطر اندلاع صراع بين روسيا والدول الأوروبية»، وذلك بعد أن أكدت الاستراتيجية إلى أن «العديد من الدول الأوروبية تنظر إلى روسيا باعتبارها تهديداً وجودياً»، غير أنه من الواضح أن إدارة ترمب لا تشاطر أوروبا هذه الرؤية.
في المقابل، وضعت الاستراتيجية عدة افتراضات، أولها أن منطقة المحيطين الهندي – الهادئ ستظل من بين ساحات الصراع الاقتصادية والجيوسياسية الرئيسية في القرن المقبل، نظراً لأن المنطقة تُعد مصدراً لما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية، وثلثه تقريباً، وفقاً للقيمة الاسمية. كما من المؤكد أن هذه الحصة ستزداد على مدار القرن الحادي والعشرين. وافترضت الاستراتيجية أنه من أجل ازدهار الولايات المتحدة، فإنه يجب أن تنافس في منطقة المحيطين الهندي – الهادئ، وأن واشنطن تمتلك القوة الاقتصادية والعسكرية والتقنية والقوة الناعمة والدعم التاريخي للحلفاء والشركاء، والذي يؤهل واشنطن للفوز في هذه المنافسة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الصين هو المنافس الرئيس للولايات المتحدة هناك، غير أن الاستراتيجية عمدت إلى إغفال ذكرها صراحة.
أما الافتراض الثاني للاستراتيجية، فهو أنه إذا ظلت أمريكا على مسار نمو، مع حفاظها على علاقة اقتصادية مع بكين مفيدة للطرفين حقاً، فيجب أن ينمو حجم الاقتصاد الأمريكي البالغ 30 تريليون دولار في عام 2025 إلى 40 تريليون دولار خلال العقد الرابع من الألفية الثانية، مما يحافظ على وضع الاقتصاد الأمريكي كأكبر اقتصاد في العالم .

ثالثاً: حماية المصالح الأمريكية
نصت الاستراتيجية الأمريكية السابقة في عهد إدارة بايدن، والصادرة في عام 2022، على عدة مصالح أبرزها حماية الشعب الأمريكي، وتوسيع الفرص الاقتصادية، والدفاع عن القيم الديمقراطية. ولتحقيق هذه الاستراتيجية كان هناك تركيز على تقوية الاقتصاد والتحالفات، والانتصار في المنافسة الاستراتيجية مع دول مثل روسيا والصين.
ويبدو أن ترامب رأى أن بعض هذه الأهداف عامة وغير واقعية، مثل الدفاع عن القيم الديمقراطية، أو الانتصار على روسيا. لذا أكدت استراتيجية ترامب على مصالح الولايات المتحدة، والتي عرفتها بشكل محدد، وواضح، على إنها تتمثل في استقرار نصف الكرة الغربي، لمنع الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع التواجد الأجنبي المعادي للمصالح الأمريكية هناك. ورأت الاستراتيجية كذلك أنه يدخل ضمن المصالح الأمريكية وقف الضرر الذي يفرضه الفاعلون الأجانب على الاقتصاد الأمريكي، في إشارة ضمنية إلى تحقيق الحلفاء والخصوم (مثل الصين) مزايا غير عادلة في التجارة مع الولايات المتحدة. كما أكدت الاستراتيجية على ضمان حرية الملاحة، في إشارة ضمنية إلى الحفاظ على الممرات المائية حول العالم، سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو في جنوب شرق أسيا محمية من أي اعتداءات أو تحكم من قوى أجنبية.
ويأتي من ضمن المصالح التي نصت عليها الاستراتيجية كذلك استعادة أوروبا هويتها الغربية، ومنع الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، وخاصة إمدادات النفط والغاز. وأخيراً، استمرار ريادة الولايات المتحدة للعالم في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمومية.
أما فيما يتعلق بالتهديدات، أعادت الولايات المتحدة تعريف التهديدات بشكل أقل حدة عن الاستراتيجيات السابقة، إذ لم تعرف روسيا والصين باعتبارهما مهددين للأمن القومي الأمريكي، بل وعند الحديث عن منطقة الشرق الأوسط، أشارت الاستراتيجية إلى تراجع تنافس القوى الكبرى إلى مجرد «مناورات»، وهو ما يعكس سعي الاستراتيجية إلى الحد من اللهجة التصعيدية مع روسيا والصين.
ومع ذلك، فإن الاستراتيجية نصت على ضرورة مواجهة واشنطن التهديدات النابعة من الدولتين، فقد أشارت الاستراتيجية، على سبيل المثال، إلى أن الولايات المتحدة «ستمنع المنافسين غير المنتمين إلى نصف الكرة الغربي من نشر قوات أو قدرات مهددة أخرى، أو من امتلاك أو السيطرة على أصول استراتيجية حيوية»، وهو ما يعد إشارة ضمنية إلى روسيا والصين، إذ أن الأولى تتمتع بعلاقات دفاعية مع بعض دول المنطقة المناوئة لواشنطن، مثل فنزويلا، في حين أن الثانية، تسعى للتمدد في مناطق استراتيجية في أمريكا اللاتينية، مثل قناة بنما. وأشارت الاستراتيجية إلى أهمية تعزيز الانتشار العسكري في أمريكا اللاتينية لمواجهة «التهديدات العاجلة» في المنطقة. كما أكدت الاستراتيجية في موضع أخر على أن «شؤون الدول الأخرى» سوف تمثل هواجساً للولايات المتحدة فقط إذا ما كانت أنشطة هذه الدول تهدد مصالحنا .
وفي المقابل، فإن أكبر تهديد للولايات المتحدة نابع من الحدود، وتحديداً ما وصفته الاستراتيجية بـ «الغزو»، ليس فقط من الهجرة غير المنضبطة، ولكن كذلك للتهديدات العابرة للحدود الأخرى، مثل الإرهاب والمخدرات والتجسس والإتجار في البشر. ويلاحظ أن الهجرة تشغل هاجساً رئيساً عند ترامب لأنها تضعف من الهوية الغربية للولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهي نقطة سيتم تفصيلها لاحقاً.
رابعاً: الموازن من الخارج
تعكس الاستراتيجية الجديدة إيماناً قوياً بمبادئ المدرسة الواقعية، بدءاً من التسليم بتحوّل النظام الدولي إلى نظام متعدد الأقطاب، والتخلي عن محاولات إدامة الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، وهي الاستراتيجية التي ظلت حاكمة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، بدءاً من إدارة جورج بوش الأبن، وسياسته الخارجية والأمنية، والتي كانت تميل إلى الأحادية، والميل إلى تغيير النظم المناوئة لواشنطن تحت ستار نشر الديمقراطية حول العالم، فضلاً عن دعمها النشط لتوسيع حلف شمال الأطلسي في الفضاء ما بعد السوفييتي، وتبنيها لمشاريع تهدد الاستقرار الاستراتيجي مثل الدفاع الصاروخي، والذي كان يهدف إلى تقويض مبدأ الردع بين واشنطن وموسكو.
ولم تختلف السياسة الأمريكية زمن إدارتي باراك أوباما وجو بايدن عن السياسة السابقة، إذ نصت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في عهد بايدن على هذه النقطة تحديداً، وذلك بإشارتها إلى أنه «ليس هناك أمة في وضع أفضل لكي تقود العالم بقوة ورؤية واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية»، وكذلك إشارتها إلى أن «حقبة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت بشكلٍ حاسم، وهناك منافسة جارية بين القوى الكبرى لتشكيل ما سيأتي لاحقاً. ولا توجد دولة تتمتع بموقع أفضل لتحقيق النجاح في هذه المنافسة من الولايات المتحدة»، فالصيغتان السابقتان، وإن أقرت بتحوّل شكل النظام الدولي، وتعترف بصعود المنافسة بين القوى الكبرى، فإنها لم تتخل عن مساعي الهيمنة الأمريكية، وهو ما يتضح من تأكيدها أن واشنطن في موقع أفضل للفوز بهذه الحرب.
وعلى النقيض من ذلك، فإن إدارة ترامب تخلت عن طموح الهيمنة، والذي أدى إلى إنهاك القوة الأمريكية، ويتضح ذلك من مراجعة الاستراتيجية الجديدة التي لم تشر صراحة إلى صعود منافسات القوى العظمى، ولو لمرة واحدة، بل أشارت في مرة واحدة إلى «التنافس الاستراتيجي»، مع إشارة ضمنية، وليست صريحة، إلى الصين، إذ رأت أن الحفاظ على توازن قوى تقليدي مواتٍ لواشنطن يظل عنصر ضروري للتنافس الاستراتيجي، ثم تحدثت الاستراتيجية في أعقاب ذلك عن أهمية تايوان.
ومن جهة ثانية، تتخذ استراتيجية ترامب نبرة أكثر تصالحية تجاه المنافسين، إذ يصوّر التحدي على إنه «إدارة العلاقات الأوروبية مع روسيا» والعمل على «إعادة التوازن في العلاقة الاقتصادية لأمريكا مع الصين». وفي الوقت نفسه، يقدّم «التأثير المفرط للدول الأكبر والأغنى والأقوى» باعتباره «حقيقة أزلية في العلاقات الدولية»، وهو ما يعني تسليم الولايات المتحدة بتحوّل النظام الدولي إلى نظام متعدد الأقطاب، لذا ترفض الولايات المتحدة «مفهوم الهيمنة العالمية الذي لن يكون مآله إلا الفشل» وتدعم «توازنات القوى العالمية والإقليمية». والمغزى أن الولايات المتحدة أقل تركيزاً على المنافسة الاستراتيجية وأكثر انفتاحاً على فكرة مناطق النفوذ .
وتكشف كل هذه المواقف عن انتقاد الاستراتيجية لرؤية النخب الأمريكية في الفترة التالية على انتهاء الحرب الباردة، والتي كانت تعتقد في أن استمرار الهيمنة الأمريكية على العالم يخدم مصالح واشنطن. ولذلك تؤكد استراتيجية ترامب الجديدة، وبحزم، أن الولايات المتحدة ترفض مفهوم الهيمنة لنفسها، غير أن ذلك بالتبعية يعني كذلك أن الولايات المتحدة سوف تسعى لمنع أي قوة من الهيمنة على النظام الدولي، وذلك من خلال الحفاظ على توازن القوى الدولي والإقليمي، عبر العمل مع الحلفاء والشركاء .
وهنا تلعب التحالفات دوراً محورياً في الاستراتيجية الأمريكية، ولكن مع اختلافات واضحة، بين دور التحالفات في الاستراتيجية الأمريكية زمن الإدارات السابقة، ودورها في عهد ترامب، إذ أنه منذ الحرب الباردة، شكّلت التحالفات، سواء بشكل رسمي، أو غير رسمي، محوراً أساسياً في الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة. واعتقد الرؤساء المتعاقبون على حكم الولايات المتحدة، من مختلف الاتجاهات السياسية، أن التحالفات الرسمية في أوروبا وشرق آسيا، إلى جانب الالتزامات غير الرسمية في الشرق الأوسط، تُعد ضرورة لحماية المصالح الأمريكية، إذ أنها تساعد واشنطن على الإفلات من فوضى النظام الدولي، وما يستتبعه ذلك من مخاطر قد ترتد على الداخل الأمريكي نفسه.
ووفقاً لوجهة النظر هذه، فإن التكاليف السياسية والعسكرية التي تتحملها واشنطن للحفاظ على هذه التحالفات تعد ضئيلة، مقارنة بتكاليف الحروب والصراعات التي قد تترتب على تراجع الدور الأمريكي. وبالتالي، مثّل هذا الاعتقاد الراسخ حلاً سحرياً لواشنطن، إذ أنها تساعد على طمأنة الحلفاء وردع الخصوم، غير أن إدارة ترامب رأت أن حلفاء الولايات المتحدة استغلوا هذه التحالفات، ودفعوا واشنطن لتحمل العبء الأمني الأكبر، وتحولوا إلى راكبين مجانيين للمظلة الأمنية الأمريكية، بل وورطوها أحياناً في صراعات لا تخدم المصالح الأمريكية. ولذلك، شرعت إدارة ترامب لتغيير سياساتها ودفع الحلفاء إلى لعب دور أكبر في هذه التحالفات، عبر رفع إنفاقهم الدفاعي على سبيل المثال.
وتقترب رؤية الإدارة الأمريكية تلك من فكرة «الموازن من الخارج» (Offshore Balancer)، والتي طرحها كل من جون ميرشايمر وستيفان والت، منذ العام 2016، باعتبارها السياسة المثلى للولايات المتحدة، والتي تقوم على تخلى واشنطن عن الجهود الطموحة لإعادة تشكيل المجتمعات الأخرى، وتركّز على الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، ومواجهة القوى المهيمنة المحتملة في أوروبا، وشمال شرق آسيا، والخليج العربي، وذلك من خلال تشجيع الدول الأخرى في هذه الأقاليم على تولّي زمام المبادرة في كبح القوى الصاعدة، على أن تتدخل هي بنفسها فقط عند الضرورة. تتجسد هذه الرؤية في استراتيجية ترامب الجديدة، والتي تنص صراحة على مفهومين رئيسيين في هذا الإطار، وهما «تقاسم الأعباء» (Burden Sharing)، و»نقل الأعباء» (Burden Shifting)، وتنص الاستراتيجية صراحة على أن «أيام اضطلاع الولايات المتحدة بدعم النظام العالمي بأسره قد ولّت»، مشيراً إلى أنه من بين حلفاء وشركاء الولايات المتحدة عشرات الدول الغنية والمتقدمة التي يجب أن تتحمّل المسؤولية الأساسية عن مناطقها، وأن تسهم بدرجة أكبر في دفاعنا الجماعي، كما في إلزام حلف شمال الأطلسي دوله بإنفاق 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ويضمن هذا النهج، وفقاً لواشنطن، أن تُوزَّع الأعباء بشكل عادل.
وعلى الرغم من أن البعض يرى أن استراتيجية ترامب الجديدة قد لا تكون محل إجماع داخلي في واشنطن، فإن الرئيس الأمريكي، في واقع الأمر، يعبّر عن تيار قوي داخل الولايات المتحدة، ويحظى بدعم شعبي. ففي استطلاع رأي أجراه مركز بيو في عام 2016، عبّر نحو 57٪ من الأمريكيين على أن الولايات المتحدة «يجب أن تركز على حل مشاكلها، وأن تترك الأخرين يتعاملون مع مشاكلهم، بأفضل ما يستطيعون». وسعت الاستراتيجية للدفاع عن هذا التوجه الجديد من خلال الإشارة إلى «إعلان الاستقلال» و»الآباء المؤسسين»، والذين، وفقاً للاستراتيجية عبّروا عن تفضيل واحد، وهو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقبل مناقشة رؤية واشنطن للحلفاء في أقاليم العالم المختلفة، ينبغي ابتداءً معالجة البعد المتعلق بمسألة تغيير النظم، نظراً لأنها إحدى القضايا الملتبسة في السياسة الأمريكية.
خامساً: التخلي عن تغيير النظم!
يرى ميرشايمر ووالت أن سياسة الهيمنة الأمريكية أدت إلى إخفاقات في السياسة الخارجية، إذ أنها لم تمنع سيطرة روسيا على القرم، أو تصاعد النفوذ الصيني في مياهها الإقليمية، بل وتسببت في سقوط العالم العربي في حالة من الاضطراب. يرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى سياسة الولايات المتحدة الرامية إلى إحداث تغيير في الأنظمة في العراق وليبيا، وهو الأمر الذي ترتب عليه حدوث فوضى إقليمية خرج من رحمها تنظيم داعش. يرى ميرشايمر ووالت أن ذلك يرجع إلى تبني الإدارات الأمريكية المتعاقبة، الديمقراطية والجمهورية، على حد سواء، لمبادئ الهيمنة الليبرالية وسياسة تغيير النظم.
ويبدو أن الاستراتيجية الجديدة تتفق مع ميرشايمر ووالت في تقييماتهما، خاصة فيما يتعلق بسياسة تغيير النظم. وليس أدل على ذلك تصريح مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، إن استراتيجية واشنطن السابقة المتمثلة في «تغيير الأنظمة أو بناء الدول» قد انتهت في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد أكدت جابارد، أنه «على مدى عقود، ظلت سياستنا الخارجية محاصرة في حلقة غير مثمرة لا نهاية لها لتغيير الأنظمة، أو بناء الدول». وأكدت أن هذه السياسة اكسبت واشنطن «أعداء أكثر من الحلفاء»، كما أنها كبدتها إنفاق تريليونات وخسارة عدد لا يحصى من الأرواح، وفي كثير من الحالات التسبب في وجود تهديدات أمنية أكبر».
لذلك أكدت استراتيجية ترامب على أن الولايات المتحدة تسعى لإقامة علاقات طيبة وتجارية سلمية مع دول العالم، من دون أن تفرض عليها الديمقراطية، أو أي تغيير اجتماعي آخر يختلف اختلافاً كبيراً عن تقاليدها وتاريخها. كما أشارت الاستراتيجية في موضع أخر إلى «إعلان الاستقلال»، وتحديداً فكرة أن جميع الأمم لها الحق في «مكانة منفصلة ومتساوية» فيما بينها. وأخذاً في الاعتبار كلا النقطتين السابقتين، فإن إدارة ترامب تلمح إلى أنها ستسلك على نحو مماثل نهج «عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى»، وهي السياسة التي تؤكد عليها الصين وروسيا، وتعد جاذبة لدول العالم الثالث. وعلى الرغم من رفض ترامب سياسة تغيير النظم، فإنه يمكن المجادلة بأن واشنطن لن تتخلى تماماً عن هذه السياسة، ولكن قامت فقط بتحديد نطاقه الجغرافي، إن جاز التعبير، فبموجب الاستراتيجية الجديدة، فإنه من حق واشنطن التدخل، أو التأثير على نصف الكرة الغربي، في إعادة إحياء لعقيدة مونرو، أو ما أسماه ترامب «مبدأ ترامب المكمّل» لعقيدة مونرو، بالإضافة إلى أوروبا، والتي تمثل امتداداً حضارياً للولايات المتحدة.
وهناك مؤشرين على ذلك الأمر، الأول ورد ذكره في الاستراتيجية، بينما الثاني يمكن تلمسه من متابعة السياسة الأمريكية الحالية تجاه فنزويلا. وفيما يتعلق بالمؤشر الأول، حذرت الاستراتيجية من «احتمال محو حضاري» لأوروبا، مشيرة إلى أنه «من المرجّح جداً أنه في غضون بضعة عقود على أبعد تقدير، ستصبح بعض دول الناتو ذات أغلبية غير أوروبية»؛ ولذا تدعو الاستراتيجية الأمريكية إلى اتخاذ خطوات لمساعدة القارة على «تصحيح مسارها الحالي»، وهو ما نظر إليه على أنه دعماً أمريكياً صريحاً لليمين المتطرف في الدول الأوروبية، والذي ينادي بنفس مبادئ تقريباً، خاصة فيما يتعلق بوقف الهجرة، والحفاظ على الطابع المسيحي لأوروبا.
وقد وضح أهمية هذا البعد بالنسبة لترامب، حينما سأل المسؤولين المنتخبين علناً «لماذا لا نستقبل أشخاصا من السويد أو النروج؟»، في إشارة إلى رفضه لاستقبال لاجئين من خارج الدول الغربية، كما أن بعض الأشخاص المقربين من ترامب يتبنون هذا الأمر، مثل أيلون ماسك، والذي عبّر عن دعمه الصريح للبديل من أجل ألمانيا، وهو أحد الأحزاب الأوروبية اليمينية، كما أن هذا الحزب تحديداً أشاد بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي التي حذّرت من زوال الحضارة الأوروبية، وأعلن الحزب الألماني، في مطلع ديسمبر 2025، عن زيارة حوالي 20 نائباً من صفوفه للولايات المتحدة للاجتماع بمسؤولين في الحزب الجمهوري، وذلك بهدف «نسج شراكات متينة مع القوى التي تدافع عن السيادة الوطنية والهوية الثقافية والسياسة الواقعية في مجال الأمن والهجرة»، وهو ما قد ينظر إليه على إنه تدخلاً واضحاً في الشؤون الأوروبية. ولذلك، انتقد المستشار الألماني ميرتس الاستراتيجية قائلاً إن «جزءاً منها غير مقبول لنا من منظور أوروبي»، في إشارة إلى الجزء الوارد في الاستراتيجية المتعلق بإنقاذ الديمقراطية في أوروبا.
أما المؤشر الثاني على النطاق الجغرافي لسياسة تغيير النظم، فيتضح من السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، خاصة بعد تسريب مسؤولين أمريكيين، في ديسمبر 2025، عن وضع واشنطن خطط لما بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والحشد العسكري الأمريكي بالقرب من فنزويلا، وتهديدها بتوجيه ضربات جوية لها، في مسعى للضغط على مادورو لدفعه للاستقالة. وبالتالي، يمكن القول إن السياسة الأمريكية تجاه نصف العالم الغربي وأوروبا تختلف عن باقي مناطق العالم، إذ تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ مختلفة ذات أولويات متباينة، وهو ما سيتم تفصيله في النقطة التالية.
سادساً: إعادة ترتيب أقاليم العالم:
حذرت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، في عام 2022، من أن أكبر تحدٍ استراتيجي تواجه الرؤية الأمريكية هي من القوى التي تجمع ما بين الحكومات السلطوية وسياسة خارجية «تعديلية» (Revisionist Foreign Policies)، أي تسعى إلى تعديل وتغيير النظام الدولي القائم، وكان رد الاستراتيجية على هذا التحدي هو الانتصار في المنافسة على الصين، وتقييد روسيا العدوانية. ولم يختلف التقييم السابق عن تقييم استراتيجية الأمن القومي الأمريكية للرئيس ترامب في فترة إدارته الأولى والصادرة في عام 2017، فقد أكدت استراتيجيته صراحة عن عودة صراعات القوى العظمى، واصفةً الصين وروسيا بأنهما قوتان «تعديليتان» تسعيان إلى تقويض الهيمنة الأمريكية حول العالم.
وتبدل الموقف الأمريكي تماماً، في ظل إدارة ترامب الثانية، إذ أكدت أن القوى الكبرى يمكنها أن تتعايش من خلال الحد من التدخل في أقاليم بعضها البعض، وهو ما يعد تسليماً عملياً بعودة مناطق النفوذ، ونتاج مباشر لإخفاق الولايات المتحدة الأمريكية في هزيمة روسيا في أوكرانيا. وقد عبرت الاستراتيجية الأمريكية عن هذه الرؤية صراحة، حينما وجهت انتقادات حادة إلى الأوروبيين، إذ أكدت أن «إدارة ترامب تجد نفسها على خلاف مع المسؤولين الأوروبيين الذين يحملون توقعات غير واقعية بشأن الحرب» الروسية – الأوكرانية، في إشارة ضمنية إلى وجود توقعات غير منطقية بإمكانية هزيمة روسيا.
لذا، تتبنى إدارة ترامب سياسة تنادي بشكل صريح بتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، بحيث تتمتع كل قوة عظمى بحرية في ممارسة نفوذها وهيمنتها داخل مناطق نفوذها، وهو ما يعني ضمناً أن الولايات المتحدة قد تقبل بضم روسيا لأراضٍ أوكرانية، ولكن ذلك في مقابل توقف موسكو عن التدخل في أمريكا اللاتينية، أو الفناء الخلفي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه بمراجعة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، يلاحظ أن واشنطن لا تقبل بمنح الصين نفس الوضع، أي أنها لن تقبل بسيطرتها على تايوان، بل وتعمل على ردع بكين من شن عملية عسكرية تستطيع بموجبها استعادة السيطرة على أراضيها.
وبموجب الاستراتيجية الجديدة، فإنه لن يتم التركيز على كل ركن في العالم، كما كان الحال في الاستراتيجيات السابقة، إذ أن ذلك الأمر «جعل واشنطن تفتقد التركيز، وهو النقيض لما يجب أن تكون عليه الاستراتيجية»، كما تؤكد استراتيجية ترامب صراحة. وتبرر الاستراتيجية ذلك التوجه على أساس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتحمل تكلفة أن تكون منتبهة لكل مناطق ومشاكل العالم.
لذلك تضع الاستراتيجية العالم نصف الكرة الغربي باعتبارها المنطقة ذات الأولوية، وتؤكد إدارة ترامب هنا على إحياء مبدأ مونرو، أي أن تكون واشنطن هي المهيمن الرئيس على هذه المنطقة، وذلك عبر اتباع استراتيجية تقوم على الاستعانة بالحلفاء الراسخين هناك للسيطرة على الهجرة، ووقف تدفقات المخدرات، وتعزيز الاستقرار والأمن برياً وبحرياً، بالإضافة إلى التحالف مع شركاء جدد، وذلك من خلال تعزيز جاذبية الولايات المتحدة كشريك اقتصادي وأمني مفضل في نصف الكرة الغربي. كما ستسعى الولايات المتحدة إلى إقناع حكومات أمريكا اللاتينية برفض التعاون مع القوى الأخرى من خارج نصف الكرة الغربي، وإيضاح أن التعاون مع مثل هذه الدول يتضمن تكاليف خفية، مثل التجسس، وتهديد أمن هذه الدول السيبراني، بالإضافة إلى إيقاع دول المنطقة في مصيدة الديون، في إشارة ضمنية إلى الصين، وإذا ما وافقت الدول على وقف مثل هذا التعاون، فإن واشنطن سوف تتعاون معها اقتصادياً وتكنولوجياً، وتقدم لها خدمات وسلع أفضل. وسوف تكون أداة واشنطن في هذا الإطار هو الأداة الاقتصادية، وذلك عبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الأمريكي.
أما ثاني المناطق من حيث الأهمية، فتتمثل في أسيا، وتبرر الاستراتيجية ذلك على أساس أن منطقة المحيطين الهادئ – الهندي هي مصدر لنصف الناتج القومي الإجمالي العالمي بالقيمة الحقيقية تقريباً، كما سلفت الإشارة، ولذلك، فإن هذه المنطقة سوف تظل أهم مناطق الصراعات الاقتصادية والجيوبوليتيكية خلال القرن القادم. ومرة أخرى، ترى الولايات المتحدة أنها الأجدر على المنافسة بنجاح هناك بسبب احتفاظ واشنطن بأقوى اقتصاد وجيش في العالم، وابتكار يتفوق على الجميع، و»قوة ناعمة» لا مثيل لها، وسجل تاريخي في إفادة حلفائها وشركائها. وتخص الاستراتيجية بالذكر هنا الهند، وضرورة أن تحسن الولايات المتحدة علاقاتها بالأخيرة وتشجيع نيودلهي على المساهمة في أمن المحيطين الهادئ والهندي، بما في ذلك من خلال التعاون الرباعي مع أستراليا واليابان والولايات المتحدة في إطار «الكواد». وتؤكد الاستراتيجية هنا أن محور التعاون مع الحلفاء في هذه المنطقة يتمثل في منع هيمنة منافس استراتيجي واحد على المنطقة في إشارة ضمنية إلى الصين.
تؤكد الاستراتيجية هنا أن التوازن العسكري التقليدي يظل مكوّناً أساسياً من عناصر التنافس الاستراتيجي في إشارة ضمنية مرة أخرى إلى التنافس بين الصين والولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، تؤكد الاستراتيجية على الأهمية الكبيرة لتايوان، بسبب هيمنتها على إنتاج أشباه الموصلات، وبسبب موقعها الجغرافي، الذي يسمح بالوصول المباشر إلى سلسلة الجزر الثانية وتفصل بين شمال شرق وجنوب شرق آسيا إلى مسرحين متميزين، ولأن ثلث الشحن العالمي يمر سنوياً عبر بحر الصين الجنوبي. وتؤثر هذه العوامل السابقة مباشرة على الاقتصاد الأمريكي. ومن ثم فإن ردع نشوب صراع حول تايوان يعد أولوية. تؤكد الاستراتيجية كذلك إلى أن الجيش الأمريكي لا يمكنه، ولا ينبغي أن يضطر إلى، القيام بذلك بمفرده، إذ أنه سيكون واجباً على حلفاء واشنطن، وتحديداً اليابان وكوريا الجنوبية، أن يقوما بزيادة الإنفاق العسكري، مع التركيز على امتلاك قدرات دفاعية جديدة لردع الخصوم وحماية سلسلة الجزر الأولى، في إشارة مبطنة إلى الصين. وارتباطاً بالتهديد السابق، تنص الاستراتيجية الأمريكية على تحد أمني ذات صلة، وهو السماح لأي منافس، في إشارة ضمنية إلى الصين كذلك بالتحكم في بحر الصين الجنوبي، نظراً لأن هذا الأمر يمثل تهديداً للمصالح الأمريكية . ولم تغفل الاستراتيجية البعد العسكري في المنافسة مع الصين وروسيا، وإن تحاشت الاستراتيجية الإشارة إليه صراحة، إذ حددت الدرع الصاروخي «القبة الذهبية» كهدف استراتيجي، وهو عبارة عن «أنظمة دفاع صاروخي من الجيل التالي» لحماية الولايات المتحدة وأصولها في الخارج وحلفائها. ومن الواضح أن هذه القبة تهدف إلى الرد على التفوق الروسي – الصيني في إنتاج الصواريخ الفرط صوتية، والتي تعجز نظم الدفاع الجوي الأمريكية الحالية عن مواجهتها، كما باتت قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن تايوان محل شك، خاصة بعدما كشف «تقرير سري للغاية» صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، وجرى تسريبه للصحافة في ديسمبر 2025، أن الولايات المتحدة ستتكبد «هزيمة ساحقة» وستفقد أكبر حاملة طائرات لديها إذا حاولت منع الصين من غزو تايوان بسبب ترسانة الصين التي تضم نحو 600 سلاح فرط صوتي، إلى جانب الصواريخ والغواصات النووية. وبالتالي باتت الولايات المتحدة في حاجة إلى منظومة دفاع جديدة قادرة على كسر التفوق الصيني، واستعادة الردع لمنع الصين من ضم تايوان بالقوة.
أما القارة الأوروبية، فقد احتلت المرتبة الثالثة، في قائمة اهتمامات الاستراتيجية الأمريكية. وهنا تحذر الاستراتيجية من المشاكل الأوروبية، والتي لا تتمثل فقط في تراجع الإنفاق العسكري والركود الاقتصادي، مع تراجع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 25٪ في عام 1990 إلى 14٪ فقط اليوم، ولكن كذلك إلى ما أسمته الاستراتيجية بـ «خطر المحو الحضاري»، والذي أرجعته الاستراتيجية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي تحد من الحرية السياسية والسيادة، فضلاً عن دعم سياسات الهجرة، والتي تهدد الهويات الوطنية، وتجعل من الصعب التعرف على القارة خلال عشرون عاماً أو أقل، إذ تؤكد الاستراتيجية أن بعض الدول الأوروبية سوف تصبح أغلبية من غير الأوروبيين، وهو ما قد يدفعهم إلى إعادة التفكير في تحالفهم مع الولايات المتحدة.
وبالنسبة للعلاقات مع روسيا، فإن الاستراتيجية ترى أن مصلحة رئيسية للولايات المتحدة هو التفاوض على وقف الحرب في أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في القارة الأوروبية، ومنع توسع الحرب، واستعادة الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا. وهنا توجه الاستراتيجية انتقاداً حاداً إلى أوروبا، إذ تؤكد أن أغلبية الأوروبيين يرغبون في السلام، غير أن هذه الرغبة لا يتم ترجمتها إلى سياسة، بسبب تخريب الحكومات للعملية الديمقراطية. ومع ذلك، فإن أوروبا تظل مهمة للمصالح الأمريكية، نظراً لأنها أحد أعمدة الاقتصاد العالمي، والازدهار الأمريكي، ولذلك تدعو الاستراتيجية إلى ضرورة توظيف الدبلوماسية من أجل ديمقراطية حقيقة، وإحياء الشخصية الوطنية لكل دولة أوروبية، وتؤكد الاستراتيجية أن الفرصة المتاحة أمام الولايات المتحدة لاستغلالها ودعمها هو الأحزاب الوطنية (اليمينية المتطرفة).
وجاء الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة بالنسبة للولايات المتحدة. وترى الاستراتيجية أن تراجع مرتبة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية الأمريكية لا يرتبط بعدم أهمية المنطقة، ولكن نظراً لأنها لم تعد مصدر رئيس لكوارث وشيكة كما كان عليه الحال في الماضي. وتؤكد الاستراتيجية أن هذه المنطقة احتلت تاريخياً الأولوية فوق كل المناطق الأخر، وذلك لأسباب واضحة، وهي أن أهم منتج للطاقة، ومسرح رئيسي لمنافسة القوى العظمى، كما أنها تعاني من صراعات قد تمتد إلى مناطق أخرى في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وترى الاستراتيجية أن سببين من الأسباب الثلاثة لم تعد قائمة، إذ أن الولايات المتحدة صارت مصدّر صافٍ للنفط، كما أن الولايات المتحدة تحتل رقماً مهماً في الشرق الأوسط بسبب الإحياء الناجح لتحالفاتها مع الخليج والدول العربية الأخرى وإسرائيل. أما صراعات المنطقة، فقد تراجعت بسبب إضعاف إيران بعد عملية «مطرقة منتصف الليل» في يونيو 2025، والتي قوضت البرنامج النووي الإيراني. ونظراً لذلك، ترى واشنطن أن أسباب واشنطن التاريخية للتركيز على الشرق الأوسط تراجعت، ومع ذلك، فإن المنطقة تحتل أهمية كبيرة بسبب أنها مصدر ومقصد للاستثمارات العالمية والصناعات، مثل التكنولوجيا النووية والذكاء الاصطناعي. وترى الاستراتيجية أن مفتاح النجاح في الشرق الأوسط هو في تقبل المنطقة وقادتها وشعوبها، كما هي، والعمل معهم من أجل تحقيق المصالح المشتركة، والتي تتمثل في عدم سقوط موارد الطاقة في المنطقة في أيدي قوى معادية، أو إغلاق مضيق هرمز، أو تهديد الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن ضمان عدم تحول المنطقة إلى حاضنة للإرهاب، أو مصدر تهديد لإسرائيل. لذلك تدعم واشنطن الدبلوماسية لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية لتضم دول أخرى. ولاشك أن تحقيق اتفاقات السلام، في المنطقة وحول العالم، يقلل من فرص تورط واشنطن عسكرياً، ويساهم في تفرغ واشنطن لصراعها الأهم مع الصين.
في الختام تكشف مراجعة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي عن حدوث تحولات عميقة، إذ أنها تضع أهدافاً أكثر واقعية عن الاستراتيجيات السابقة، فلم تعد تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها المدافعة عن «النظام الدولي القائم على القواعد»، ولكن فقط المدافعة عن نصف الكرة الغربي، وحماية الثقافة الأوروبية من الفناء بسبب تهديد «المهاجرين».
أما السمة الثانية الغالبة على الاستراتيجية، فتتمثل في تجنبها الإشارة صراحة إلى التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة من جانب، والصين وروسيا من جانب أخر. وبالنسبة لروسيا، يبدو أن الولايات المتحدة قد أسقطتها من حساباتها باعتبارها عدو أو خصم استراتيجي، بل وترى أنها سوف تسعى إلى الوساطة بينها وبين أوروبا لاستعادة الاستقرار في أوكرانيا.
أما الصين، فإن الاستراتيجية ركزت في أكثر من مرة على أهمية احتواء الصين، اقتصادياً وعسكرياً، في جنوب شرق أسيا، لضمان عدم تحولها إلى مهيمن على منطقة المحيطين الهادئ – الهندي، وإن تحاشت الاستراتيجية الإشارة إلى الصين صراحة، كما أكدت أنه يأتي من ضمن المصالح الأمريكية منع ضم الصين لتايوان، لأن ذلك سوف يخل إخلالاً شديداً بتوازن القوى. وسوف تقوم واشنطن بذلك من خلال التحالفات ودفع حلفائها للعب دور أمني أكبر. وعليه، يمكن القول إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة باتت عملياً تطبق استراتيجية «الموازن من الخارج».
أما منطقة الشرق الأوسط، فلاتزال تتمتع بأهمية مركزية بسبب الطاقة وممراتها الملاحية واستثماراتها المفيدة للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن الاستراتيجية تهون كثيراً من مساعي روسيا، أو الصين في التواجد في المنطقة، كما أنها تبالغ في تقدير حجم الاستقرار الإقليمي، خاصة وأن أزمة البرنامج النووي الإيراني أو حتى القضية الفلسطينية لم يتم علاجها بشكل كامل. ومع ذلك، فإن النهج الأمريكي الرئيس بات يتمثل في تحميل أقاليم العالم المختلفة مسؤولية لعب دور أمني رئيسي في مناطقها، وأن تقوم واشنطن بلعب دور أقل مركزية في هذه التحالفات.
د. شادي عبدالوهاب
أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني