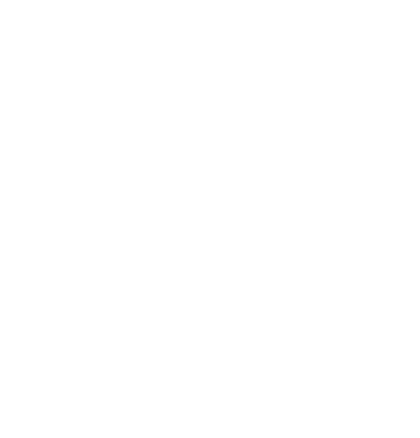أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2025، عن مشروع «القبة الذهبية»، وهو نظام دفاعي طموح يسعى لتحويل الفضاء إلى خط الدفاع الأول للولايات المتحدة ضد الهجمات الصاروخية المعقدة. يهدف المشروع إلى إنشاء شبكة من الأقمار الاصطناعية، الصواريخ الاعتراضية، ومراكز القيادة الذكية التي تتكامل معاً لتكوين مظلة فضائية تحمي أراضي أمريكا من التهديدات الباليستية والصواريخ الفرط صوتية. يُذَكِّر هذا المشروع بالمشروع السابق الذي سبق وأن أعلن عنه الرئيس الأمريكي، رونالد ريجان، في ثمانينات القرن العشرين، والذي كان يعرف باسم «مبادرة الدفاع الاستراتيجي». ويثير هذا الأمر التساؤل حول فرص نجاح هذا المشروع، وانعكاساته على سباق التسلح المحتمل مع روسيا والصين.

بهدف فهم الخطوة الأمريكية بإنشاء القبة الذهبية، لا بد ابتداءً التطرق إلى الردع النووي، ونوعيه الرئيسيين، نظراً لأن الخطوة الأمريكية تؤثر على الردع النووي بين القوى الكبرى. ويستند الردع النووي على مبدأ معروف، وهو «التدمير المتبادل المؤكد»، أي أنه في حالة استخدام الدولة (أ) للسلاح النووي ضد الدولة (ب)، فإن الدولة (ب) سوف تتمكن من استيعاب الضربة الأولى، وضمان البقاء حتى تتمكن من توجيه ضربة نووية ثانية ضد الدولة (أ)، وهو الأمر الذي يعني أن مثل هذه الهجمات سوف تكون انتحارية للجانبين، وهو ما يعمل على منع استخدام السلاح النووي من الأساس، طالما أن النتيجة النهائية لاستخدامه هو تحقيق تدمير متبادل مؤكد لطرفي الصراع.
وفي إطار نظريات الردع النووي، يتم التمييز بين قدرات الانتقام ضد الأهداف ذات القيمة العالية، وقدرات الضربات المضادة. وتركز الأولى على توجيه الأسلحة النووية ضد اقتصاد العدو وسكانه. وكانت مثل هذه القدرات أسهل وأرخص في التنفيذ على مدار التاريخ، كما كانت الركيزة الأساسية التي يستند إليها «التدمير المتبادل المؤكد»، أي أن كل طرف يجب أن يكون لديه ما يكفي من القوة النووية لتدمير مجتمع الطرف الآخر. وفي المقابل، فإن «قدرات الضربات المضادة»، تركز على توجيه ضربات دقيقة على قوات العدو النووية العسكرية ومنشآته وأصوله. ومن ثم، تستهدف نزع سلاح قوات العدو النووية، وبالتالي تقويض الأساس الذي يقوم عليه الردع النووي، غير أن هذا الأمر كان مستحيلاً في الواقع العملي، لأن ترسانات القوى العظمى كانت كبيرة وموزعة على مناطق متعددة، كما كان من السهل إخفاؤها وحمايتها، ولذلك كان يتعذر تدمير كامل القدرات النووية للخصم.
ويجادل البعض بأن التكنولوجيا العسكرية الحديثة تقوض من أسس الردع النووي، نظراً لأنها تعزز من فرص تطوير التكنولوجيات العسكرية التي تستند إليها «قدرات الضربات المضادة»، سواء من خلال التقدم في مجال الاستطلاع عبر الأقمار الاصطناعية، وتنامي القدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، والذي يؤهل الدول لاكتشاف منصات إطلاق الصواريخ النووية المتحركة، أو من خلال التقدم في القدرات المتعلقة بالحرب ضد الغواصات، بالإضافة إلى نظم الدفاع الجوي، والتي توظف مركبات مسيرة، ومجسات متقدمة ونظم ذكاء اصطناعي متطورة تؤهلها إلى تحليل كم هائل من البيانات، ومن ثم تساعد كل هذه الأسلحة المتقدمة في رصد المنظومات النووية للخصم، الثابتة والمتحركة، وبالتالي يمكن أن تخل من الردع النووي، من خلال امتلاك الدول للقدرة على تدمير قدرات الخصم النووية، فضلاً عن امتلاك القدرة على اعتراض صواريخه النووية. وفي هذا الإطار، يمكن فهم خطة ترامب لامتلاك الولايات المتحدة «القبة الذهبية»، والتي تشبه في جوهرها مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس ريجان، وكذلك نظام الدفاع الصاروخي الأرضي لبوش الابن. فالقبة الذهبية تستهدف إحياء الهيمنة النووية الأمريكية في مواجهة خصوم واشنطن، وتحديداً روسيا والصين، عبر امتلاك القدرة على اعتراض كافة الصواريخ الباليستية والمجنحة والفرط صوتية الحاملة لرؤوس نووية.
تاريخ من المحاولات الفاشلة
يلاحظ أن الدفاع عن الولايات المتحدة من الصواريخ ذات الرؤوس النووية ليست فكرة جديدة. ففي الخمسينات والستينات من القرن العشرين، جربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي صواريخ نووية «دفاعية» تهدف إلى اعتراض الرؤوس الحربية القادمة وتدميرها، غير أن هذه الجهود لم تنجح في النهاية، وباءت جميعها بالفشل.
وفي ثمانينات القرن العشرين، جاءت إحدى أبرز المحاولات الأمريكية، وأكثرها شهرة على الإطلاق، والتي عرفت باسم «مبادرة الدفاع الاستراتيجي»، واشتهرت إعلامياً باسم «حرب النجوم»، إذ قررت إدارة الرئيس، رونالد ريجان، إنهاء نظام الردع النووي القائم على مبدأ «التدمير المتبادل المؤكد»، والذي يهدف إلى تحقيق الهيمنة النووية الأمريكية من خلال التهديد بالرد النووي الشامل على أي هجوم نووي، مع تعزيز قدرة الولايات المتحدة على اعتراض أغلب الصواريخ النووية، أي أن تتمكن واشنطن من إبادة خصومها نووياً بشكل كامل، مع إمكانية أن تتحمل خسائر محدودة، تتمثل في موت ملايين من الأشخاص في بعض مناطق الدولة، ولكن ليس الدولة كلها.
وكان ريجان يهدف إلى تطوير قدرة مؤكدة على توجيه الضربة الأولى عن طريق اختراع نظام «ذكاء اصطناعي» عرف باسم «برنامج الحوسبة الاستراتيجية» للتحكم في درع دفاعي فضائي مضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، قادر على إطلاق أشعة الليزر والصواريخ والقذائف على أي أسلحة قادمة. ومن خلال زيادة دقة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى متر واحد تقريباً، حسبت الولايات المتحدة أنها تستطيع توجيه ضربة «قاضية» ناجحة على الاتحاد السوفييتي، مع امتصاص الهجمات النووية السوفييتية المقابلة بواسطة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مع تقدير بوجود خسائر أمريكية مقبولة (في حدود عدة ملايين قليلة). وبالتالي، ستتم استعادة الهيمنة النووية الأمريكية.
وأكد العديد من المبرمجين والمتخصصين أن «جميع محاولات نمذجة الواقع بالاعتماد على برامج هي بطبيعتها ذات صفة اختزالية» أمر مستحيل، نظراً لاستحالة الأخذ في الاعتبار كافة العوامل الموجودة في الواقع العملي. وأكد ديفيد لورجي بارناس، أحد أكثر مبرمجي الحوسبة العسكرية خبرةً في ذلك الوقت، أنه «يجب أن تتعامل البرمجيات مع العديد من المواقف (أو الحالات) الفريدة من نوعها، وهو ما يجعل من المستحيل إجراء اختبار كامل»، كما أكد أن تصرفات العدو والتعديلات التي يدخلها على سلوكه في ميدان المعركة تعني وجود درجة عالية من التعقيد وعدم يقين يستحيل التغلب عليه من خلال أنظمة الكمبيوتر.
وفشل مشروع «حرب النجوم» بسبب فشل أكثر البرامج تعقيداً في ذلك الوقت، في بناء نموذج للواقع، وكذلك بسبب صعوبة التنبؤ بالسلوك الإنساني نفسه. فالواقع شاسع للغاية من جميع النواحي، بحيث لا يمكن للبشر معرفة سوى جزء ضئيل منه. وغالباً ما يدّعي صانعو السياسات والعلماء أنهم يفهمون أكثر بكثير مما يعرفونه عن العالم الحقيقي.
أما ثاني هذه المحاولات، فقد جاءت في عهد الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، حينما أطلق في العام 2002، «نظام الدفاع الصاروخي الأرضي» (GMD)، والذي يهدف إلى اكتشاف إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قبل العدو، وتدمير رأسه الحربي النووي في منتصف المسار قبل أن يصل إلى أراضي الولايات المتحدة. ويتم ذلك من خلال أجهزة الاستشعار الموجودة على الأقمار الاصطناعية المخصصة للإنذار المبكر، والتي ترصد اللهيب الساطع للصاروخ عند إطلاقه، وكذلك من الرادارات المتمركزة في مواقع قريبة من الخصم، وسوف تكتشف هذه الأنظمة الصاروخ خلال دقيقة واحدة تقريباً، أو أقل من بدء عملية الإطلاق، ويمكنها تزويد الجهات المختصة بمعلومات أولية، على الأقل، حول مسار الصاروخ خلال عشرات الثواني اللاحقة.
وبعد تحليق الصاروخ في الفضاء الجوي، يتم إرسال المعلومات الأولية من جانب الرادارات السابقة إلى رادار تتبع أرضي، والذي يمتلك القدرة على توفير بيانات تتبع دقيقة للصواريخ المعادية، بما يكفي لاستخدامها في إطلاق وتوجيه الصواريخ الاعتراضية. واستناداً إلى المعلومات الواردة من جميع أجهزة الاستشعار المتاحة، ستحاول مراكز التحكم في إطلاق الصواريخ المعادية وتمييز الرأس الحربي عن الأجسام الأخرى كالشراك الخداعية، وتحديد مساره، وحساب نقاط الاعتراض المحتملة، وإطلاق صاروخ اعتراضي واحد أو أكثر. وسيعتمد عدد الصواريخ الاعتراضية التي سيتم إطلاقها في البداية على عوامل مختلفة، بما في ذلك ما إذا كان المشغلون يعتقدون أنه تم تحديد الرأس الحربي بدقة، أو إذا كان هناك حاجة إلى اعتراض أجسام متعددة، وما إذا كان هناك وقت لإطلاق جولة ثانية من الصواريخ الاعتراضية بعد تحديد نتائج محاولات الاعتراض الأولى. ويلاحظ أن تكلفة هذا المشروع كانت مرتفعة، فقد قدر أنه تكلفته بلغت حوالي 63 مليار دولار حتى العام 2024، في حين أن كفاءته ظلت مثار جدل، حيث يرى كثيرون أن تجارب الاعتراض أظهرت عدم قدرة النظام على توفير الدفاع الموثوق ضد الصواريخ المعادية حتى في مواجهة هجوم محدود، إذ تشير نسبة نجاحه البالغة 57 %، في إطار الاختبارات التي تم إجراؤها، إلى احتمال كبير بأن عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBMs) قد تتمكن من الوصول إلى الأراضي الأمريكية في حال وقوع مثل هذا الهجوم.
فقد أكد تقرير حكومي أمريكي، في العام 2017، أن نظام الدفاع الصاروخي له قدرة محدودة على حماية أراضي الولايات المتحدة من أعداد صغيرة من التهديدات البسيطة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، أو العابرة للقارات التي تطلق من دول مثل كوريا الشمالية أو إيران. وحتى عندما تم إصدار تقييم مغاير بتاريخ 6 يونيو 2017، وأكد أن النظام «أثبت قدرته» على الدفاع في مواجهة الصواريخ السابقة، فإنه أشار إلى أن ذلك في مواجهة عدد قليل من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى التي تستخدم «تدابير مضادة بسيطة». وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تتراجع قدرة النظام في مواجهة دول أكثر تقدماً. كما أكد باحثون من اتحاد العلماء المهتمين في تقرير صدر في نفس العام إلى أن الاختبار الوحيد لنظام الدفاع الصاروخي العالمي ضد هدف من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات «تم تبسيطه بطرق مهمة عززت فرصة نجاح الاختبار بدلاً من تحدي النظام للعمل في ظروف تحاكي الظروف الواقعية».
وحتى لو تم النظر إلى نظام الدفاع الصاروخي الأرضي، باعتباره جزءاً من منظومة دفاع صاروخي متكاملة للولايات المتحدة، والتي تضم كذلك منظومتي ثاد وإجيس، فإن نسبة النجاح لا تتجاوز نسبة 78.8 %. وبالتالي، فإنه من المرجح أن يتمكن عدد من الصواريخ الباليستية، والتي يتم إطلاقها في موجة محدودة العدد من الصواريخ ينفذها طرف مثل كوريا الشمالية أن تجاوز هذه الدفاعات، وهو ما يعني أن فاعلية هذه المنظومات سوف تتراجع بشدة في مواجهة دولة نووية متقدمة، مثل روسيا أو الصين، واللتين تمتلكان ترسانة نووية ضخمة.
مشروع الهيمنة النووية مجدداً
أكد الرئيس ترامب أن القبة الذهبية ستحقق مشروع «حرب النجوم» الذي أطلقه رونالد ريجان في ثمانينات القرن العشرين لحماية أمريكا من الصواريخ النووية القادمة، إذ صرح قائلاً: «سنكمل حقاً المهمة التي بدأها الرئيس ريجان قبل 40 عاماً، وننهي إلى الأبد التهديد الصاروخي للوطن الأمريكي».
ويعتمد نظام القبة الذهبية على مكونات متطورة تضم آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة ذات المدار المنخفض، مجهزة بأنظمة استشعار فائق الحساسية قادرة على تعقب الأجسام بسرعة تفوق 20 ماخ (1ماخ = 1234 كم/س).
وإلى جانب الأقمار الاصطناعية، سيتم بناء وحدات إطلاق فضائية متنقلة وثابتة قادرة على إرسال صواريخ اعتراضية تعمل بتقنية الليزر والميكروويف، إضافة إلى صواريخ اعتراضية تقليدية مصممة لاعتراض الأهداف من الطبقة العليا للغلاف الجوي وحتى المدار القريب. وستُدار هذه المنظومة بواسطة شبكات ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على اتخاذ قرارات فورية بناءً على تحليل بيانات ميدانية ضخمة، وهو ما يعني أن الاستجابة لأي تهديد ستكون أسرع من أي نظام دفاعي سابق. ويُنتظر أن يكون النظام قادراً على التكامل مع أنظمة الدفاع الحالية مثل آجيس، وثاد، وباتريوت، مما يخلق شبكة متعددة الطبقات من الحماية.
وتستمد «القبة الذهبية» تسميتها من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي الممول من الولايات المتحدة، كما أكد ترامب نفسه بشكل ضمني أنه تم استيحاء الاسم من المنظومة الإسرائيلية، فقد أكد ترامب أن الولايات المتحدة «ساعدت إسرائيل في منظومتها، وكانت ناجحة للغاية، والآن لدينا تكنولوجيا متقدمة جداً عن ذلك… صواريخ تفوق سرعة الصوت، وصواريخ باليستية وصواريخ كروز متطورة، سيتم إبعادها جميعاً من الجو».
وعلى الرغم من تصريحات ترامب السابقة، فإن هناك ملاحظتين أساسيتين عليها، أولهما يتعلق بمدى قدرة المنظومة على اعتراض الصواريخ، فقد أكدت شركة «رافائيل» المصنعة أن نسبة الاعتراض الناجحة للمنظومة تبلغ 90 %، وهي تهدف بالأساس إلى صد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 مليمتراً. ولكن في الواقع العملي، لاقت هذه المنظومة تحديات كبيرة، إذ إن «القبة الحديدية» عرضة لهجمات «الإشباع»، أي إطلاق عدد كبير من الصواريخ من اتجاهات متعددة في توقيت واحد، بما يفوق قدرة المنظومة على التعامل مع جميع الأهداف في الوقت ذاته، وهو ما يؤدي، في النهاية إلى شلل المنظومة. وخلال المواجهة بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، اعترف أحد كبار المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين بأن فاعلية المنظومة تراجعت إلى 65 % فقط، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسباب ذلك. ويكشف ما سبق أنه لم يتم تطويل نظام دفاع جوي قادر على اعتراض كافة التهديدات بعد.
وثانياً، أن الصفة المميزة الأخرى، والتي تتسم بها القبة الحديدية، ويمكن أن تعتمد عليه القبة الذهبية الأمريكية، فهو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إذ تتألف «القبة الحديدية» من وحدة رادار ومركز تحكم يمكنهما التعرف إلى المقذوفات الطائرة، مثل الصواريخ، وحساب مسارها ونقطة سقوطها المتوقعة. ولا يتم إطلاق الصواريخ الاعتراضية إلا عندما يتوقع النظام سقوط الصاروخ على مناطق مأهولة، أما إذا كان التقدير بأن الصاروخ سوف يسقط في البحر، أو في مناطق غير مأهولة، فلا يتم اعتراضه. ويعني ما سبق أمرين، أولهما أنه من الصعب توقع، في ضوء الخبرة الإسرائيلية، أن تكون «القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ لو تم إطلاقها من جهات أخرى من العالم، أو لو تم إطلاقها من الفضاء»، وفقاً لما تعهد به ترامب. وصحيح أن التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية تفوق نظيرتها الإسرائيلية بدون أي شك، فإنه في المقابل، فإن منظومات الدفاع الجوي كانت تتعامل مع صواريخ إيرانية متوسطة المدى، ولم تتعامل مع الصواريخ الأكثر تعقيداً، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، أو الصواريخ الفرط صوتية، التي تمتلكها روسيا، أو الصين.
من جهة أخرى، فإن إسرائيل دولة صغيرة للغاية، ولذلك، فإنه من الممكن تغطيتها بأنظمة مثل الرادارات ومجموعة من الصواريخ الاعتراضية المتحركة والثابتة، ولكن هذا الأمر غير قابل للتحقيق في حالة الولايات المتحدة، بسبب ضخامة المساحة الجغرافية.
كما يشير متخصصون إلى تحديات أخرى، فوفقاً للجمعية الفيزيائية الأمريكية، فإن وجود صاروخ اعتراضي واحد في المدار لا يكون في المكان والوقت المناسبين لاعتراض إطلاق صاروخ باليستي بسرعة، وبالتالي فإنك تحتاج إلى عدد كبير جداً من الصواريخ الاعتراضية لضمان التغطية الكافية. وقدرت الجمعية في دراسة لها في مايو 2025: «أن هناك حاجة إلى كوكبة من حوالي 16,000 صاروخ اعتراضي لمحاولة التصدي لوابل سريع من عشرة صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، مثل صاروخ هواسونغ – 18 الكوري الشمالي. وبطبيعة الحال، فإن هذا العدد الكبيرة من الصواريخ سوف يتكلف ميزانية ضخمة، ولا يبدو أن واشنطن جاهزة لتحمل هكذا تكاليف.
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس ترامب أن المشروع الجديد سيتم إنجازه في غضون ثلاث سنوات تقريباً، أي بحلول موعد مغادرته منصبه، وهو جدول زمني قصير للغاية. فقد استغرق بناء مبادرة الدفاع الاستراتيجية عدة سنوات، واستهلك عشرات المليارات من الدولارات قبل إلغائه في النهاية، بسبب العقبات التقنية والاقتصادية الجسيمة، التي واجهها. وبالمثل، فإن الدرع الصاروخي الأمريكي بلغت كلفته حوالي 63 مليار دولار، وذلك على مدار عقدين من الزمان (2004 – 2024). ولذلك، ليس من المتوقع أن يتمكن ترامب من إنجاز القبة الذهبية في ثلاث سنوات فقط.
وإلى جانب ما سبق، فإن هناك تحديات من الصعب تجاوزها، إذ إن الولايات المتحدة لاتزال في مراحلها الأولى لتطوير صواريخ فرط صوتية، ومن المفترض أن تطور أول صواريخها من هذه النوعية بنهاية العام 2025، إذا صارت الخطط الأمريكية وفقاً للمخطط، غير أن هذا سوف يعني أنه سوف يكون واشنطن قد جسرت الفجوة مع روسيا بعد مضي حوالي سبع سنوات من إنتاج الأخيرة لهذه المنظومات، كما أنه سوف يكون لزاماً على الولايات المتحدة الدخول في جهود إضافية لتطوير نظم دفاعية جديدة في مواجهة هذه النوعية من الصواريخ الفرط صوتية، وهو تحد تقني هائل، شبهه البعض بأنه يستهدف محاولة اعتراض رصاصة باستخدام رصاصة أخرى.

معضلة الدفاع – الهجوم
على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول أن تسوق قبتها الذهبية باعتباره مشروعاً دفاعياً، يهدف إلى تأمين الولايات المتحدة، فإنه في جوهره لا يختلف عن مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس ريجان، أو نظام الدفاع الصاروخي الأرضي للرئيس بوش الابن، والذي يهدف إلى امتلاك القدرة على رصد التهديدات بالصواريخ الباليستية أو الفرط صوتية الصادرة من الدول الأخرى وتدميرها قبل أن تهدد الولايات المتحدة، وهو ما يعني تقويض إحدى أسس الردع النووي كما تمت الإشارة سابقاً، إذ أن هدف المشروع الأمريكي، في النهاية، هو حرمان القوى المناوئة لها، خاصة روسيا والصين من تطوير قدرة موثوقة على توجيه ضربة نووية ثانية في حالة تلقى الدولتين هجوماً نووياً من واشنطن.
ولذلك وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مايو 2025، مشروع القبة الذهبية بأنه يقوض الاستقرار الاستراتيجي بشكل مباشر، موضحة أنه: «في إطار بناء نظام القبّة الذهبية، من المخطط إعطاء دفعة إضافية لتطوير وسائل الاستهداف المسبق لصواريخ العدو وبنيته التحتية التي تضمن استخدامها. وهذا يعبر بالفعل عن توجه خطير في العقيدة الأمريكية، التي تعتمد على شن ضربات استباقية، إن هذا النهج مغامر ويشكل تهديداً مباشراً لأسس الاستقرار الاستراتيجي».
ولم يختلف الموقف الصيني عن نظيره الروسي، إذ أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في 21 مايو 2025، أن الصين «قلقة للغاية» بشأن مشروع «القبة الذهبية» الأمريكي، مؤكداً أنه يحمل «تداعيات هجومية» ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. ووصفت الخارجية الصينية المشروع بأنه يعكس سعي الولايات المتحدة لتحقيق الأمن المطلق، وهو ما ينتهك مبدأ عدم المساس بأمن جميع الدول، ويقوض التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي. وحثت واشنطن على التخلي عن تطوير النظام في أقرب وقت ممكن واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين القوى الكبرى.
وبغض النظر عن الشكوك التي تحيط بمدى فاعلية المشروع، أو مدى نجاح واشنطن في تنفيذه خلال مدى زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات، فإنه من المؤكد أن تسعى القوى الكبرى الأخرى، خاصة روسيا والصين لتطوير قدرات عسكرية تستهدف الرد على المشروع الأمريكي.
وهناك سوابق تاريخية على ذلك، فقد قامت الولايات المتحدة، في 13 يونيو 2002، في عهد الرئيس بوش، بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية المبرمة عام 1972 وشرعت واشنطن في بناء نظام الدفاع الصاروخي الأرضي. وكانت الاتفاقية السابقة تستهدف الحد من سباق التسلح، واستندت المعاهدة إلى فرضية أنه إذا أنشأت أي من القوتين العظميين دفاعاً استراتيجياً، فإن الأخرى ستبني قواتها النووية الهجومية لموازنة هذا الدفاع. وبالتالي، سرعان ما ستُدفع القوتان العظميان نحو سباق تسلح هجومي – دفاعي لا نهاية له، حيث تسعى كل منهما إلى موازنة أفعال الأخرى. وقد حدث ذلك بالفعل عقب إعلان واشنطن بناء دفاعها الاستراتيجي في ذلك الوقت، فقد أدى ذلك إلى شروع موسكو في تطوير صواريخ فرط صوتية بعد انسحاب واشنطن من معاهدة 2002، وذلك بهدف تطوير نظم صاروخية جديدة ذات سرعات عالية تعجز المنظومات الأمريكية الدفاعية عن اعتراضها، ومن ثم الحفاظ على الردع النووي مع واشنطن. وصحيح أن موسكو كانت تجري أبحاثاً على الصواريخ الفرط صوتية منذ الثمانينات، فإن جهودها هذه تسارعت بعد انسحاب واشنطن من المعاهدة السابقة. ومن اللافت أن روسيا والصين سبقت الولايات المتحدة في إنتاج هذه النوعية من الصواريخ، بل وأصبحت روسيا أول دولة في العالم تستخدم هذه الصواريخ.
وفي المقابل، تدافع واشنطن عن مشروع القبة الذهبية على أساس أن روسيا والصين تطوران قدرات عسكرية في الفضاء الخارجي، إذ اتهمت واشنطن روسيا في فبراير 2024، بتطوير سلاح مضاد للأقمار الصناعية يعمل بالطاقة النووية، وهو ما أثار تكهنات حول ما إذا كان الحديث هنا عن قمر اصطناعي للحرب الإلكترونية يعمل بمفاعل انشطاري، أو جهاز تفجير نووي، بالإضافة إلى اتهام واشنطن للصين بتطوير «نظام القصف المداري الجزئي» ونشر طائرة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام. كما حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، في مايو 2025، من أن الصين قد تجمع عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية في غضون 10سنوات تقريباً. وأياً كانت صحة المزاعم الأمريكية، فإنه من المؤكد أن هناك جولة جديدة من سباق التسلح قد بدأت بين القوى الكبرى الثلاث، وتحديداً روسيا والصين والولايات المتحدة.
كما لا يمكن استبعاد أن الخطوة الأمريكية هي خطوة تفاوضية تستهدف تعزيز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة مع روسيا والصين في أي مفاوضات جديدة تستهدف الحد من التسلح، وإن كان من الواضح أن مثل هذا الأمر يبدو مستبعداً في ظل تصاعد الصراعات الدولية بين القوى السابقة، سواء بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا، أو بين واشنطن وبكين حول تايوان.
وفي الختام، يثير المشروع الأمريكي الجديد تساؤلات جوهرية حول مدى فاعليته، خاصة وأن ترامب استهدف بالمشروع إعادة «إحياء حرب النجوم»، أو مبادرة الدفاع الاستراتيجي، وهو المشروع الذي أخفق إخفاقاً كبيراً، وهو ما يثير التساؤل هل يلاقي قبة ترامب الذهبية نفس مصير مبادرة الدفاع الاستراتيجي، أم ينجح في تحقيق ما عجز عنه ريجان. ويرتبط بذلك تساؤل آخر، وهو هل التكنولوجيا العسكرية الحالية قد نضجت بشكل كافٍ لتحويل القبة الذهبية إلى حقيقة واقعة، أم لا يزال هناك حاجة إلى سنوات إضافية من التطوير لهذه التكنولوجيات.
د. شادي عبدالوهاب منصور أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني