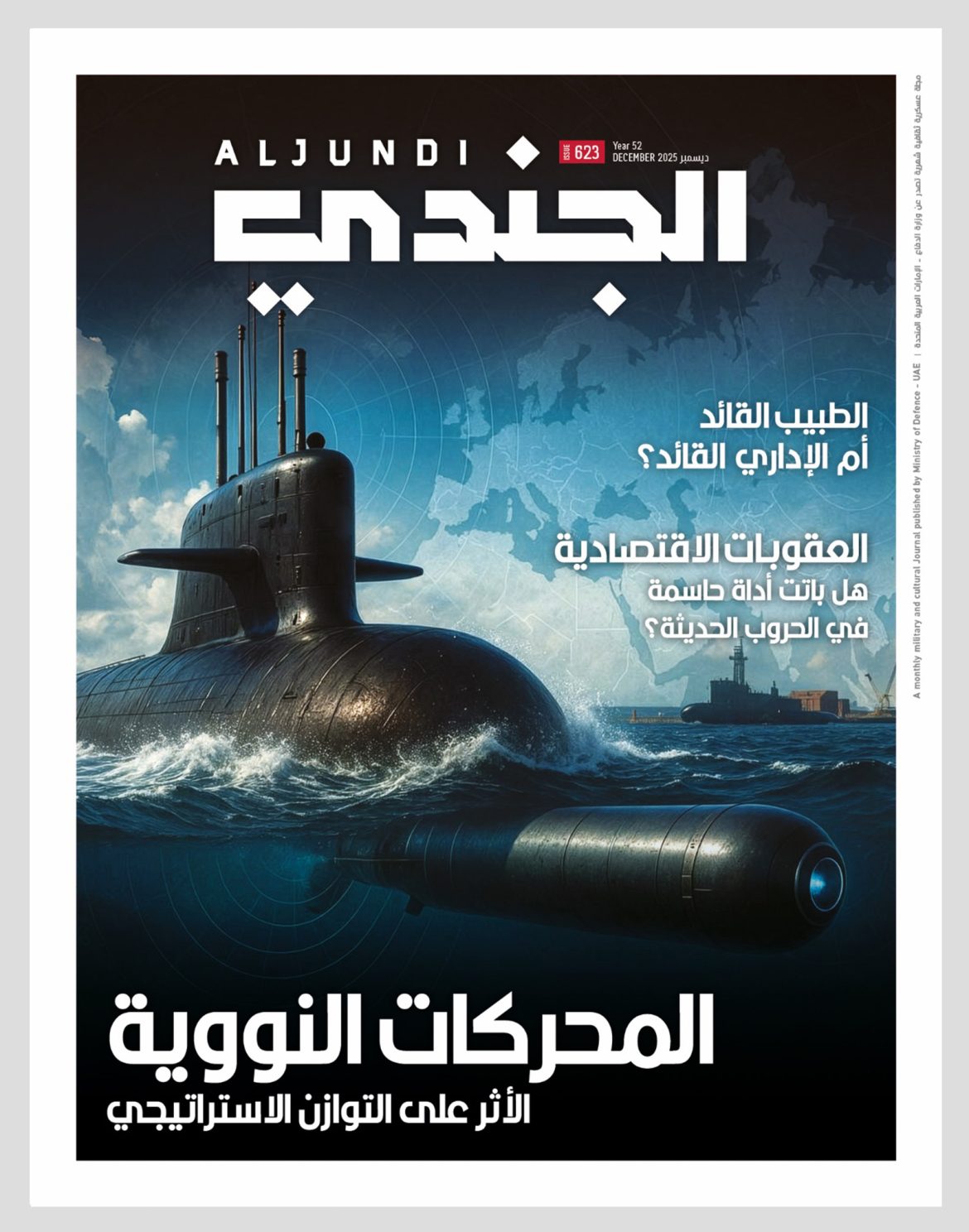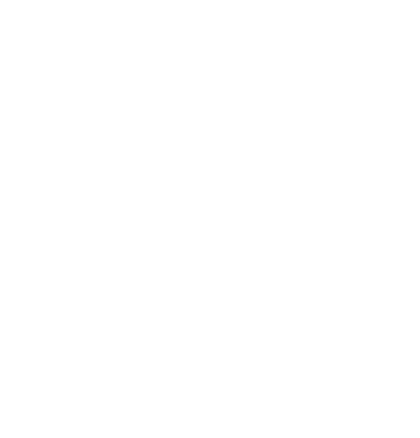يزخر التاريخ العسكري بالعديد من الأمثلة على قيام القادة السياسيين أو العسكريين بإشعال فتيل نزاعات دولية مكلفة تفشل فيها الدولة عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أخفقت دول عدة في تحقيق أهدافها في أكثر من نصف الأزمات الدولية التي بدأتها، ويرتبط هذا الأمر بوجود تقدير خاطئ في الأغلب من الحالات لقوة الخصم، أو قدرته على تحمل الضربات العسكرية الموجعة. وفي هذا الإطار، يلاحظ أن الجيش الروسي قد بنى توقعات خاطئة لمدى صمود الجيش الأوكراني في مواجهة الهجوم الكاسح الذي شنّه الأول ضد أوكرانيا في عام 2022. وبالمثل، ظنّت الولايات المتحدة أن هجوم القوات الأوكرانية ضد روسيا في منتصف 2023 سوف يمكنها من استعادة نسبة كبيرة من الأراضي التي سيطرت عليها الأخيرة. ويثير ما سبق التساؤل حول أسباب الخطأ في الحسابات مع التطبيق على حالة الحرب الروسية – الأوكرانية.

نبدأ هنا بفرضية رئيسية، وهي أن الخطأ في الحسابات لا يرتبط بأحد طرفي الصراع، ولكنه قد يرتبط بكليهما، غير أن العامل الحاسم في تحقيق النصر هو إدراك أحد الطرفين لأسباب الإخفاق وتبنيه مسارات عمل تصحيحية تأخذ في الاعتبار الحقائق المتكشفة والوقائع الجديدة، ويلاحظ أن هذا الطرف هو الذي سوف يتمكن من تصحيح مساره وتجنب الخسارة الاستراتيجية. وسوف تسعى المقالة لاختبار صحة هذه الفرضية من خلال التطبيق على حالة الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تزعم المقالة أن كلا الطرفين قد ارتكب خطئاً في الحسابات.
أولاً: مسببات الحسابات الخاطئة:
تتعدد الأسباب التي تقف وراء سوء الحسابات من قبل القادة السياسيين، أو العسكريين، وبمراجعة الأدبيات المتعلقة بقراري الحرب والسلام، يمكن حصر أبرز هذه الأسباب في التالي:
1. سوء الإدراك للنوايا والقدرات: قامت مجموعة متنوعة من المنظرين والمتخصصين في حقل العلاقات الدولية، بدءاً من ثوسيديدس إلى مورجنثاو ببناء نماذج «عقلانية» للصراع، تفترض أن رجال الدولة يدركون بدقة التهديدات والفرص الخارجية، ويختارون سياساتهم بناء على حساب دقيق للتكلفة والعائد، وذلك بهدف تعزيز المصالح الوطنية. وتكشف العديد من الأمثلة التاريخية عن خطأ هذا التصور، إذ يلاحظ أن سوء إدراك قادة إحدى الدول لنوايا وقدرات خصومها تكون مسبباً رئيسياً للخطأ في الحسابات، والتي تساهم في اتخاذ قرار غير مدروس بشن الحرب. ويميل محللو الدفاع إلى بناء التوقعات على القدرات العسكرية القابلة للقياس الكمي للخصم المحتمل، بينما تعطي الأوساط الدبلوماسية والاستخباراتية وزناً أكبر لدوافع الخصوم عند التنبؤ بالمستقبل. وفيما يتعلق بسوء التقدير في حساب القدرات العسكرية، الحالية والكامنة للخصم، فإنه يلاحظ أنه في بعض الحالات يكون هناك ميل للمبالغة في تقدير القدرات العسكرية الذاتية مقابل الانتقاص من القدرات العسكرية للخصم، وهو الأمر الذي يؤدي بثقة عسكرية مبالغ فيها تدفع باتجاه تبني الدولة لقرار الحرب.
وفي حين أن هناك أبعاداً مادية قابلة للقياس في قدرات العدو، مثل القوة العسكرية والاقتصادية والديمغرافية، فإن هناك أبعاداً أخرى يكاد يكون من المستحيل إحصاؤها، أو تقديرها، مثل الروح المعنوية وعامل القيادة، والاستخبارات العسكرية وطبيعة العقيدة العسكرية للخصم. ويعد الجهل بعقيدة الخصم وتأثيرها على مسار ونتائج الحرب بمثابة أحد المصادر الرئيسية لإساءة تقدير القدرات العسكرية للخصم. وقد يزداد سوء إدراك العامل السابق بفضل المعلومات الاستخباراتية التي تتوفر عن القدرات العسكرية للخصم، والتي تقدم تقديرات خاطئة عنها. كما أن تقييم القدرات العسكرية الكامنة أمر مهم، وذلك لأنها تلعب دوراً في تحديد مدى قدرة الدولة على خوض حروب ممتدة.
كما يأتي من ضمن الأمور التي يصعب التنبؤ بها بشكل دقيق تطور التكنولوجيات الجديدة وتطبيقها في الحرب، بالإضافة إلى القدرات الإدارية، والتي تحدد كفاءة تحويل الموارد إلى قوة عسكرية فعالة، والاعتبارات السياسية مثل الإرادة والقدرة على تحويل الموارد الوطنية إلى دعم القطاع العسكري. ففي كلتا الحربين العالميتين، على سبيل المثال، استهانت ألمانيا بالقدرة الصناعية للولايات المتحدة، وكذلك باستعدادها لتكريس مواردها للحرب.
ويدخل ضمن العوامل التي يصعب تقديرها، التقييمات الخاطئة لتأثير الحرب على التماسك والدعم السياسي لشعب الخصم، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على القدرة على خوض الحرب. قد يكون هناك ميل للافتراض، بشكل خاطئ، أن شعب الخصم ليس معادياً، أو ربما حتى متعاطفاً مع قضية الدولة المناوئة له. ومن ذلك على سبيل المثال، الافتراض السائد في الدول الغربية بأن الشعب الروسي لا يؤيد الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وذلك على الرغم من أن استطلاعات الرأي الروسية كانت تظهر أن دعم الشعب الروسي للحرب يتأرجح ما بين 70 و75 % على مدار العامين الأوليين من الحرب. وتأتي من ضمن العوامل التي تساعد على سوء الإدراك، افتراض مركزية اتخاذ القرار لدى الخصم، خاصة في أوقات الأزمات. وعلى سبيل المثال، فإنه أثناء الأزمة الكوبية، تم إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية «يو 2» أثناء تحليقها فوق كوبا في 27 أكتوبر 1962 بصاروخ سوفييتي. واعتقدت الولايات المتحدة أن القيادة السوفييتية ممثلة في نيكيتا خيرتشوف هي من أصدرت الأوامر، وقال وزير الدفاع الأمريكي، روبرت ماكنمارا، حينها «أنا لا أستطيع تفسير ما جرى». ولكن في حقيقة الأمر، تكشف الوثائق التي تم الإفراج عنها لاحقاً، أن القوات الكوبية بأوامر من الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، قاموا بإطلاق نيران المضادات الأرضية ضد الطائرات الأمريكية، خوفاً من أن تستعد الولايات المتحدة لغزو وشيك للجزيرة، وعلى الرغم من صدور أوامر صريحة من موسكو بعدم إطلاق النار دون إذن صريح من الجنرال السوفييتي المسؤول في كوبا، قام قائد وحدة الصواريخ سام المحلي، بإصدار أمر بإطلاق النار، تضامناً مع رفقائه الكوبيين، وأسقط «يو 2».
أما فيما يتعلق بالنوايا، فيلاحظ أنه قد يحدث خطأ في فهم المقصود من وراء تصريحات أو أفعال الخصم، وكذلك انعكاسها على سلوكه المستقبلي. ويلاحظ أن المبالغة في توقع عدائية نوايا الخصم هي الشكل الأكثر شيوعاً للتصور الخاطئ. وغالباً ما ينبع ذلك الأمر من الارتكان إلى تحليل نوايا الخصم بالاستناد إلى أسوأ السيناريوهات، والميل إلى تحديد النوايا من منظور القدرات المتاحة، فضلاً عن شيطنة الخصم. ومن جهة أخرى، قد يحدث سوء إدراك لنوايا وقدرات الأطراف الثالثة. ونظراً لأن احتمالية النصر والتكاليف المتوقعة للحرب تتأثر إلى حد كبير باحتمالية تدخل دول ثالثة إلى جانب طرف أو آخر وبالتأثير المتوقع لهذا التدخل على مسار الحرب، فإن التصورات الخاطئة لهذه المتغير قد يؤثر على الحساب الدقيق للتكلفة والعائد، وبالتالي قد تساهم في شن الحرب. وتندرج ضمن هذه الفئة التصورات الخاطئة لنوايا وقدرات كل من الخصوم المحتملين والحلفاء المحتملين.
2. الإنكار والخداع: يشير الإنكار إلى محاولة حجب المعلومات التي يمكن أن يستخدمها الخصم لمعرفة بعض الحقائق. أما الخداع، على النقيض من ذلك، فيشير إلى الجهود التي تبذلها دولة ما لجعل الخصم يعتقد في صحة معلومات مضللة. وعلى الرغم من أن الإنكار والخداع نشاطان مختلفان، فإنهما متشابكان في الممارسة العملية. ومن أجل خداع الخصم بشأن النوايا أو الأهداف الحقيقية للجهة المخادعة، يجب إخفاء أو «إنكار» المعلومات المهمة (على سبيل المثال، حول تطوير برنامج عسكري معين، أو سياسة، أو مسار عمل تتبعه الدولة، إلخ) عن الدولة المستهدفة. وبالتوازي يمكن ممارسة الخداع، وهو الجهد المبذول لجعل الخصم يعتقد في صحة معلومات مضللة، أو غير صحيحة، إلى جانب عمليات الإنكار. وينطوي ذلك الخداع على توظيف عمليات، مثل استخدام «التسريبات»، أو معلومات مدسوسة، أو نشر شراك خداعية لخلق انطباع بأن الحقيقة تختلف عن تلك الموجودة في الواقع، وبالتالي خلق «واقع بديل» لخداع الدولة المستهدفة. وعندما ينجح الإنكار والخداع، يقود المخادع الدولة المستهدفة إلى تصديق «القصة الملفقة» بدلاً من الحقيقة. ومن ثم تتصرف الدولة المستهدفة بطريقة تخدم مصالح المخادع. ولاشك أن الإنكار والخداع قد يؤدي إلى قيام الدولة بحسابات خاطئة.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية على الإنكار، لعل أبرزها ما جرى خلال أزمة الصواريخ الكوبية. فحتى العام 1962، لم تكن الولايات المتحدة تعرف أن السوفييت نشروا أكثر من 100 سلاح نووي تكتيكي في كوبا. وكانت هذه الأسلحة النووية الأصغر حجماً تهدف لتوفير الحماية للجزيرة ضد أي غزو بحري من قبل الولايات المتحدة. وقبل 22 أكتوبر 1962، حصل الضباط السوفييت الموجودون في الجزيرة على تصريح مسبق باستخدامها ضد قوات الغزو الأمريكية. وفي المقابل، كان الأخوان كينيدي وجميع مستشاريهم يعتقدون خطئاً أن السوفييت نشروا فقط الصواريخ النووية متوسطة المدى في كوبا، وكانت أجهزة الاستخبارات تبحث عنها، لكنها لم تتمكن من تحديد موقعها. وبالتالي، لو نفذت الولايات المتحدة تهديدها بغزو الجزيرة، لتم إبادة القوات الأمريكية المهاجمة نووياً.
وارتباطاً بما سبق، تمثل الخطأ الأكبر في المثال السابق في أن أغلبية مستشاري الرئيس العسكريين والمدنيين، والذين كانوا ينصحون الرئيس بمهاجمة كوبا، كانوا يعتقدوا خطئاً أن السوفييت لن يردوا على هذه الخطوة عسكرياً في أي مكان في العالم، كما كانوا يعتقدون أنه ليست هناك أي رؤوس نووية جاهزة عملياتياً للاستخدام في الجزيرة، بناء على تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والتي اتضح في النهاية عدم صحتها. ويكشف هذا المثال، خاصة في سياق الأزمات الدولية المعقدة، كيف أنه يجب على صانعي القرار التحسب لإمكانية وجود معلومات حيوية ناقصة قد تغير تماماً مسار عملية صنع القرار.
وفي حين أن الإنكار، في الحالة السابقة، لم يؤد إلى تداعيات كارثية، مثل الخطأ في الحسابات بصورة تؤدي إلى اندلاع حرب نووية، فإنه في حالات أخرى، قد يساهم في تورط الدولة في القتال، أو يقلل من استعدادها للقتال نتيجة لعمليات التضليل والإنكار الممارس عليها من قبل خصمها.
ومن أبرز الأمثلة التاريخية الكلاسيكية الحسابات الإسرائيلية الخاطئة، والتي تم تجسيدها فيما يعرف باسم «المفهوم»، وهي أن مصر، من وجهة نظر تل أبيب، لم تكن قادرة على تحمل بدء حرب كانت متأكدة من خسارتها، وفقاً لحسابات تل أبيب، بسبب تفوق الأسلحة الإسرائيلية، ورفض السوفييت توفير أحدث الأسلحة في فترة «التهدئة» بين القوى العظمى. وساهم في ذلك خطة التضليل والإنكار المعلوماتي التي مارسها الجانب المصري، فقد قامت مصر بنشر قوات عسكرية على طول خط القناة تحت ستار القيام بتدريبات سنوية. ففي الأعوام السابقة على عام 1973، وفي كل مرة، كانت إسرائيل تتخوف من أن مصر تخطط لتنفيذ هجوم لاسترداد سيناء، غير أنه في كل مرة تنتهي هذه التدريبات من دون أن يترتب عليها أي تهديد، ولذلك تمسكت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بالاعتقاد بأن مصر في أكتوبر 1973 كانت تقوم بتدريبات سنوية، وأن انتشار الجيش المصري كان دفاعياً بالأساس، وأن مصر لن تقوم بشن الحروب، وهو ما لم يتم هذه المرة، إذ شنّت مصر هجوماً مكنّها من تدمير خط بارليف وهزيمة القوات الإسرائيلية. أما الأنكار، فقد تمثل في إقامة حائط دفاعي من الصواريخ، والذي تضمن نوعين جديدين من نظم الدفاع الجوي، وهما نظام الدفاع الجوي «سام 6» و«سام 7»، ولم تعلم عنهما إسرائيل أي شيء قبل الحرب. كما قامت القوات المصرية بالتحرك إلى مواقع هجومية وإخفاء ذلك من خلال نقل القوات إلى الضفة الغربية من قناة السويس نهاراً ثم إعادتهم ليلاً، ولكن ما لم يدركه الإسرائيليون هو أن مصر كانت تعيد كتيبة واحدة من كل لواء، بينما اتخذت الكتائب الأخرى مواقع مخفية على طول القناة.
3. دور مؤسسات الأمن القومي: يقصد بها المؤسسات العاملة في مجال السياسة الخارجية والدفاع، مثل وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك أجهزة الاستخبارات. وتلعب هذه الوزارات والأجهزة دوراً في تشكيل قرار السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بقرار الحرب والسلام. صحيح أن القرار المتعلق بهذا الأمر يقع على عاتق القيادة السياسية للدولة، سواء تمثل في رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء، فإن هذه المؤسسات تلعب دوراً في اتخاذ مثل هذه القرارات، من خلال ما توفر من معلومات.
ولا تنشأ الأزمات الدولية بصورة مفاجئة، فهي عادة ما تكون نتيجة قرارات مدروسة من قبل القادة السياسيين الذين يوازنون بين التكاليف والفوائد. فمن ناحية، تسمح بعض الأزمات للدول بتعزيز أهدافها، ودفع الخصوم إلى تقديم تنازلات. ومن ناحية أخرى، تزيد الأزمات من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، تتسبب في أزمات مدمرة، إنسانية واقتصادية. ويميل القادة إلى تجنب إثارة الأزمات التي تفشل في تحقيق أهدافهم لأن مثل هذه الأزمات تترتب عليها تكاليف ولا تحقق فوائد.
بعض الدراسات تفترض أن التباين في التصميم المؤسسي قد يؤدي إلى أن يتخذ صانعو القرار قرارات ببدء الأزمة بناء على افتراضات غير دقيقة حول الوضع القائم. ويمكن التمييز بين عدة ترتيبات بيروقراطية لمؤسسات الأمن القومي، والتي قد يؤدي بعضها إلى سوء التقدير. النوع الأول من التصميم، هي «المؤسسات المتكاملة»، وهي المؤسسات التي تعزز من قدرة الدولة على التعامل مع أوقات الأزمات من زاويتين. أولاً، توفر المؤسسات المتكاملة المعلومات أثناء اتخاذ القرار، والتي يطلبها القادة، والتي تتعلق بتقييم احتمال نجاح الدولة في الأزمة، أو التكاليف المتوقعة، أو الاستراتيجيات البديلة المتاحة لصنّاع القرار. ثانياً، تسمح المؤسسات المتكاملة لمؤسسات الأمن القومي بتشارك المعلومات فيما بينها، وهو ما يساعد البيروقراطيين على معرفة مدى أهمية معلوماتهم للقادة، مقارنة بما توفره مؤسسات الدولة الأخرى. وبنفس القدر من الأهمية، فهي تسمح للبيروقراطيين بالرقابة على المعلومات التي تنقلها البيروقراطيات إلى القائد. ويساهم العاملان معاً في توفير قدر أكبر من المعلومات وبجودة أعلى. وبالتالي، فإن القادة الذين يجلسون على رأس المؤسسات المتكاملة هم في أفضل وضع لتحديد الأزمات التي من المرجح أن تعزز أهداف الدولة، وبالتالي تجنب المعارك غير الناجحة خارجياً. وبالمقارنة، فإن هناك نوعين آخرين من مؤسسات الأمن القومي، تزيدان من مخاطر سوء التقدير في الأزمات الدولية. ويتمثل النوع الأول في «المؤسسات المنعزلة» التي تعيق تدفق المعلومات أفقياً فيما بين مؤسسات الأمن القومي. وعلى الرغم من أن القادة يتلقون المزيد من المعلومات، فإنها تميل إلى أن تكون أقل جودة، لأن البيروقراطيين لا يستطيعون الوصول إلى تقارير بعضهم بعضاً أو التحقق منها. وهذا يخلق مسلكاً يؤدي لسوء التقدير، حيث يبادر القادة إلى افتعال أزمات دولية بناءً على معلومات بيروقراطية غير دقيقة.
أما النوع الثاني، فيتمثل في المؤسسات المجزأة، والتي تكون بموجبها المؤسسات عاجزة عن التأثير على عملية صنع القرار للقائد من خلال إمداده بالمعلومات اللازمة. ويؤدي ذلك الأمر إلى تقليص دوافع البيروقراطية للبحث عن المعلومات وتطوير الخبرات المؤسسية، كما أن المؤسسات في هذا النمط تعجز عن قول الحقيقة للسلطة، وبالتالي يتراجع دور هذه المؤسسات في تقرير مسائل الحرب والسلام، وبالتالي، يقع عبء اتخاذ مثل هذا القرار على القائد السياسي وحده، وهو ما قد يؤدي إلى قرارات متسرعة وغير مدروسة.
ويحدد القادة دور بيروقراطيات الأمن الوطني في عملية اتخاذ القرار، وبالتالي، قد يفرضون القيود على عملها. ويرى هذا الرأي أن القادة قد يرون أن المؤسسات المتكاملة قد تفرض تحدياً، أو تهديدات لمسارات الحركة التي يفضلونها، ومن ثم يعملون على إضعافها، وذلك من خلال منع تعاونها في تبادل المعلومات فيما بينها، أو من خلال منعها من المشاركة في عملية صنع القرار.
ويلاحظ أن أياً من هذه الأشكال المؤسسية السابقة يمكن أن يوجد في الدول الديمقراطية، أو الديكتاتورية على حد سواء. وعلى سبيل المثال، فإن الرئيس الأمريكي جونسون تبنى نمط المؤسسات المجزأة، وهو الأمر الذي ترتب عليه منع مؤسسات صنع قرار الأمن الوطني من إيصال معلومات تتسم بالكفاءة فيما يتعلق بخيار التصعيد العسكري في فيتنام في ستينات القرن الماضي، وذلك نظراً لخوفه من أن تقوم هذه المؤسسات بتسريب أخبار للصحافة عن مسار الحرب، وقام بمنع المشاورات داخل مجلس الأمن القومي، وأنشأ منتدى بديل منعزل يُعرف باسم «غداء الثلاثاء»، واستبعد جونسون فعلياً الأصوات المعارضة من المداولات وثبط إعادة النظر في القضايا الرئيسية المتعلقة بالحرب. وأثر هذا الأمر على جودة المعلومات المرفوعة، والتي كانت ناقصة ومحرفة بصورة تلائم المعتقدات التي كان الرئيس يحملها بالفعل.
وعلى الرغم من أهمية الإسهام النظري للرأي السابق، فإنه من الصعب رصده إلا بعد فترة زمنية طويلة، وتحديداً بعد اتجاه الدول للإفراج عن وثائقها الحكومية السرية، والتي تكشف عن المداولات التي تتم بين رئيس الدولة والأجهزة العاملة في مجال الأمن القومي. وفي ظل غياب هذه المعلومات، فإنه قد يتم الادعاء بأن قادة الخصوم يتبنون هذا النهج دون توفير أدلة كافية. وعلى سبيل المثال، مالت السردية السائدة في وسائل الإعلام الغربية للتأكيد في بداية الحرب الروسية – الأوكرانية على استئثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالسيطرة على القوات المسلحة، ورفضه السماح بأي آراء مستقلة تخالفه، وبالتالي، أبعد الأصوات الناقدة والمناقشات الصادقة في الشؤون العسكرية والدفاعية، وهو ما ورط روسيا في حرب خاسرة. وتعالت هذه الأصوات تحديداً في أوائل 2023، أي بعد نجاح أوكرانيا في شن هجومها المضاد في أواخر 2022، غير أن مثل هذا الرأي يقف عاجزاً عن تفسير أسباب انتصار روسيا على أوكرانيا في هجوم منتصف 2023، وكذلك هجوم كورسك في مطلع 2025.
ثانياً: الحسابات الخاطئة في الحرب الروسية – الأوكرانية
تقدم الحرب الروسية – الأوكرانية مثالاً جيداً على الخطأ في الحسابات من جانب الأطراف الرئيسية الفاعلة في الحرب، سواء تمثل ذلك في روسيا، أو في أوكرانيا وحلفائها من دول حلف الناتو. وقبل الشروع في تفصيل الأخطاء التي ارتكبها كل جانب، قد يكون من الملائم التمييز بين أربع مراحل أساسية في الحرب الروسية – الأوكرانية، وهي كالتالي: المرحلة الأولى، والتي بدأت منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير 2022، وحتى قبل الهجوم الأوكراني المعاكس في سبتمبر من نفس العام. وخلال هذه الفترة الأولى، سيطرت روسيا على مساحات واسعة من أوكرانيا، غير أنها أخفقت في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.
وتبدأ المرحلة الثانية في 6 سبتمبر حين نفذ الجيش الأوكراني هجوماً معاكساً في خاركيف تمكن خلالها حتى 1 أكتوبر 2022، من تحرير أغلب مناطقها، بالإضافة إلى استعادة السيطرة على مناطق محدودة في إقليم لوهانسك. واستمرت هذه المرحلة حتى يونيو – أكتوبر 2023، حينما فشل الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية. وبدأت المرحلة الثالثة، حينما أقدم الجيش الروسي، بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد بمواصلة توسيع قبضته تدريجياً على الأراضي الأوكرانية، خاصة في جنوب وشرق أوكرانيا، وسيطر على مناطق استراتيجية، مثل أفدييفكا (فبراير 2024)، أما المرحلة الرابعة، فقد بدأت مع 6 أغسطس 2024، مع توغل أوكرانيا داخل الأراضي الروسية وسيطرتها على حوالي ألف كيلومتر مربع داخل إقليم كورسك الروسي، وهي المحاولة التي تكللت بالفشل التام، مع نجاح الجيش الروسي في استعادة السيطرة على كافة أراضي كورسك بحلول منتصف مارس 2025. وخلال هذه المرحلة، فإن روسيا واصلت زخمها العسكري، وتمكنت من التقدم نحو مناطق استراتيجية، مثل بوكروفسك وتشاسف يار (أواخر 2024، وأوائل 2025).
في المرحلة الأولى من الحرب، يتمثل الخطأ الاستراتيجي الرئيسي لموسكو في سوء تقديراتها للفترة الزمنية التي سوف تسيطر خلالها على أوكرانيا، فقد كان من الواضح أن الجيش الروسي لم يتوقع أن يلاقي هذا القدر من المقاومة في كييف، بسبب اتباع الجيش الأوكراني لتكتيكات الحرب اللامتماثلة وحروب المدن، بالإضافة إلى استفادته من الدعم الغربي بالمعدات والأسلحة والاستخبارات، والتي كان من أبرزها هيمارس، وبالتالي، فقد أخطأت الحسابات الروسية في شقين، وهما تقدير القدرات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك التسليح ومعنويات الجنود، بالإضافة إلى دعم الأطراف الثالثة، والمقصود بذلك دعم دول حلف الناتو لأوكرانيا. وعلى الرغم من أن العديد من الكتابات الغربية أنبرت لتصوير أن روسيا كانت تخطط للسيطرة على أوكرانيا في غضون بضعة أيام، وأنها فشلت استراتيجياً على ذلك المستوى، فإنه في الواقع، لم يعلم أحد ماهية الأهداف الاستراتيجية للكرملين من الحرب، إلا الدائرة المقربة المحيطة ببوتين. ولم تبلور موسكو أهدافاً واضحة إلا بعد الهجوم الأوكراني المضاد في سبتمبر 2022، والذي في أعقابه أعلنت روسيا أهدافاً عسكرية واضحة، وهي أنها تسعى لضم أربعة أقاليم أوكرانية إليها، وهي لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.
وفي المقابل، فإن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه أوكرانيا في ذلك الوقت هي أنها أخطأت في حساب قوة روسيا، واستعدادها لخوض الحرب دفاعاً عن مصالحها، كما مالت حسابات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للاعتقاد بأن الدول الغربية لن تتوقف عن دعم أوكرانيا، اقتصادياً وعسكرياً، طالما أنها كانت تلعب دور رأس الحربة في صراع جيوسياسي يهدف، ضمن أمور أخرى، إلى هزيمة روسيا ومن ثم إفقادها مركزها كقوة عالمية في النظام الدولي، وبالتالي إدامة سيطرة الولايات المتحدة خصوصاً، والدول الغربية عموماً، على النظام الدولي. ولعل هذا الأمر أكده الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته، حينما صرح في أبريل 2025، قائلاً إنه «من الواضح تماماً أن هذا ليس صراعاً إقليمياً، بل صراعا عالمياً، وفي نهاية المطاف هناك جمهور سيحكم على نتيجة هذه الحرب. من سيخرج منتصراً: روسيا أم الغرب».
وعلى الجانب الآخر، جاء أحد أكبر الحسابات الخاطئة من قبل الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، والتي ظنّت في بداية الحرب، أن العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد روسيا، بالإضافة إلى الدعم العسكري لكييف، سوف يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الروسي، ومن ثم إسقاط الرئيس بوتين. ففي 26 مارس 2022، صرح الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، «بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل (في إشارة إلى بوتين) أن يبقى في السلطة»، وهو التصريح الذي كشف عن نية واشنطن تغيير الحكومة الروسية. وقبلها أكد بايدن، في 24 فبراير، «إن العقوبات لم تصمم لمنع الغزو، ولكن لمعاقبة روسيا بعد الغزو.. حتى يعرف الشعب الروسي ما جلبه (في إشارة لبوتين) عليهم. هذا هو كل ما في الأمر».
وكتب جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة البريطانية، في صحيفة الديلي تلغراف، في 27 فبراير 2022: «يجب أن يكون فشله كاملاً.. وتمكين الشعب الروسي من رؤية مدى قلة اهتمامه بهم. ومن خلال إظهار ذلك لهم، ستكون أيام بوتين كرئيس معدودة بالتأكيد. سيخسر السلطة ولن يتمكن من اختيار خليفته». وفي 1 مارس من نفس العام، قال المتحدث باسم بوريس جونسون إن العقوبات على روسيا «هي لإسقاط نظام بوتين». وتعكس مجمل التصريحات السابقة استراتيجية أمريكية طويلة الأمد لتغيير النظام في موسكو، مع اتخاذ الحرب على أوكرانيا ذريعة لها. وكان بايدن يعتقد جازماً في خطته هذه، إذ أعلن بلغة الواثق في مارس 2022 أن الروبل الروسي «تحوّل على الفور إلى أنقاض»، وأن «الاقتصاد الروسي في طريقه لخسارة نصف قيمته»، غير أن هذه التوقعات كانت خاطئة بشكل كارثي، فالاقتصاد الروسي لم ينكمش ولو بمقدار ضئيل في عام 2022، على الرغم من العقوبات الغربية غير المسبوقة، بل شهد نمواً متسارعاً في عام 2023. وبالتالي، فإن التقديرات الغربية أخطأت في تقدير حجم الدعم الشعبي الذي يتمتع به الرئيس الروسي، بوتين، داخل بلاده، واستعدادهم للتضحية في سبيل الدفاع عن وضع روسيا كقوى عظمى. كما كان هناك خطأ آخر ارتكبه الغرب، وهو اعتقاده أن الدول غير الغربية سوف تتضامن مع أوكرانيا في مواجهة روسيا، وهو ما لم يتم. صحيح أن الدول المختلفة دانت روسيا لجهة قيامها بشن عملية لغزو دولة مجاورة، غير أن الأغلبية العظمى من الدول رفضت الانصياع إلى ضغوط الغرب للانضمام إلى عقوباتهم ضد موسكو. وساهم في ذلك أن الأخيرة تقوم بتصدير منتجات من الصعب الاستغناء عنها، مثل الوقود، والغذاء وغيرهما.
في المرحلة الثانية، تمثل أكبر خطأ ارتكبته روسيا في عدم كفاية حجم القوات المخصصة للعملية العسكرية الخاصة، والتي قدرت بنحو 150 ألف جندي في بداية الحرب. وهذا الخطأ تداركته روسيا من خلال رفع عدد قواتها إلى حوالي 360 ألف جندي في عام 2023، ثم حوالي 612 ألف جندي في 2025، سواء كانوا منتشرين على خطوط القتال، أو على طول الحدود الروسية – الأوكرانية. وفي المقابل، فإن عدد القوات الأوكرانية المتورطة في قتال على طول الجبهة يقدر بحوالي 250 ألف جندي. ولا يتضمن هذا الرقم عدد القوات التي توفر التأمين والحماية للمدن الأوكرانية الأخرى.
في المرحلة الثالثة، كان من الواضح أن موسكو قد تعلمت من أخطائها السابقة، وشرعت في تصحيحها. وفي المقابل، فإن أوكرانيا، المزهوة بالمكاسب التي حققتها في المرحلة الثانية، ظنّت أنها سوف تتمكن من إحراز نصر آخر سريع على القوات الروسية يفضي بانسحابها من الأراضي التي احتلتها. وقد أكد هذا المعنى القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في حديث أجراه في 1 نوفمبر 2023، مع مجلة الإيكونوميست، والذي اعترف فيه بأن الوضع على الجبهة وصل إلى «طريق مسدود»، وأشار إلى أنه كان خطؤه الشخصي هو توقعه الانهيار السريع للقدرات العسكرية الروسية، بما في ذلك عجزها عن القيام بعمليات تعبئة قوات إضافية. واعترف زالوجني بفشل محاولات الجيش الأوكراني في اختراق المواقع الروسية بسبب غرقه في حقول الألغام، وبسبب الاستطلاع الفعال الذي قام به العدو لتجمعات القوات الأوكرانية مما سهل تدميرها. وكان السبب الآخر للفشل هو إرسال ألوية جديدة ليس لديها خبرة قتالية إلى المعركة.
وكانت هناك أخطاء أخرى في التخطيط العسكري كذلك، وهو ما وضح فيما نشرته صحيفة الواشنطن بوست، حول المداولات التي جرت بين كبار القادة في أوكرانيا وحلف الناتو حول التخطيط العسكري للحرب. فقد انتقد المسؤولون العسكريون الأمريكيون نظراءهم الأوكران بسبب عدم استخدام الجيش الأوكراني لكاسحات الألغام، أو الأدخنة لإخفاء تقدم الجيش الأوكراني باتجاه خطوط الدفاع الروسية، غير أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، رد على ذلك مؤكداً أن القادة الميدانيين لم يتمكنوا من القيام بذلك بسبب تفوق الروس وسيطرتهم على أجواء المعركة، إذ إنهم في اللحظة التي يلمحون فيها تقدم أي مدرعات أوكرانية يقوموا بتدميرها باستخدام كل الوسائل الممكنة، كما أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من المناورة بسبب كثافة حقول الألغام التي زرعها الجيش الروسي. وهنا يمكن القول إن الجيش الروسي نجح في هذه المرحلة في تحقيق هدف عسكري استراتيجي، وهو تأكيد عجز الجيش الأوكراني عن استعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا.
وعلى الجانب الآخر، فإن حسابات الجيش الروسي كانت هذه المرة موفقة، إذ إنه قام ببناء أضخم خطوط دفاعية عرفها التاريخ العسكري، وهو الخط المعروف باسم خط سوفوركين، نسبة إلى سيرجي سوفوركين، القائد الميداني العام السابق للعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. فقد تم شق أكثر من 3600 كيلومتر من الخنادق وممرات الاتصالات وأكثر من 150 ألف خندق ومخزن للمعدات، وأكثر من 45 ألف مخبأ، كما تم تجهيز أكثر من 12 ألف هيكل خرساني مسلح مسبق الصنع، وذلك على امتداد طول خط الجبهة مع الجيش الأوكراني، والمقدر بحوالي 1500 كيلومتر. ووصل عمق الخطوط الدفاعية إلى 120 كيلومتراً، وقد تم القيام بذلك كله في مدى زمني يقدر بحوالي 8 أشهر فقط.
في المرحلة الرابعة، ارتكبت أوكرانيا خطأ آخر في الحسابات، وذلك من خلال إقدامها على شن الهجوم على إقليم كورسك الروسي، إذ إن الجيش الأوكراني اضطر إلى سحب القوات الأوكرانية المدربة جيداً من على خطوط التماس مع الجيش الروسي في الجنوب والشرق، وذلك من أجل شن هجوم كورسك، والذي نجحت كييف من خلاله في تحقيق أهداف إعلامية، من خلال إظهار قدرتها على غزو أراضي لدولة عظمى، غير أنه من المنظور العسكري، أخفقت أوكرانيا في تحقيق أهدافها الأخرى، إذ إنها لم تتمكن من دفع القوات الروسية إلى سحب قواتها من جنوب وشرق أوكرانيا للدفاع عن كورسك، ومن ثم تقليص الضغط الروسي على مدينتي بوكروفسك وكوراخوف الأوكرانيتين، وفقاً لتصريحات القائد العام للقوات الأوكرانية الحالي، ألكسندر سيرسكي، غير أن موسكو لم تبتلع هذا الطعم، بل وحافظت على قوتها هناك، وقامت بمواصلة تقدمها العسكري باتجاه المدينتين. كما أن روسيا تمكنت من تحرير كل أراضيها من الجيش الأوكراني، وبالتالي خابت رهانات كييف على استخدام سيطرتها على جانب من الأراضي الروسية لمبادلتها بأراضٍ أوكرانية حال توقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات. وبنهاية المرحلة الرابعة، كانت القوات الأوكرانية تُعاني الإرهاق، ونقصاً في المجندين المدربين تدريباً جيداً، وفي الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، وتضاؤل الاحتياطيات. كما تواجه تحديات في تجديد قواتها واستبدال الفرق المُنهكة بمجندين جدد. وتزداد هذه التحديات في ظل تراجع المساعدات العسكرية الغربية.
وأخيراً، كانت موسكو تراهن منذ بداية الحرب على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا. وقد تأكد ذلك مع انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي بات غاضباً من حجم المبالغ الضخمة التي دفعتها إدارة بايدن السابقة إلى كييف، وذلك دون أن تتمكن الأخيرة من تحقيق أي انتصار عسكري. ولذلك اتجه ترامب إلى بحث فرص السلام مع روسيا، وتقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي بلغت حوالي 50 مليون دولار أمريكي فقط في أواخر أبريل 2025.
ويكشف العرض السابق كيف أن الأطراف الرئيسية في الصراع قامت باتخاذ عدد من القرارات الخاطئة، غير أن موسكو نجحت في تعديل خططها العسكرية، وتجنب الوقوع في أخطاء جديدة، وذلك على عكس أوكرانيا، والتي تبنت حسابات خاطئة في هجومها المضاد الثاني لاستعادة السيطرة على الأراضي المحتلة في الجنوب، أو في هجومها الثالث في كورسك، وهو ما جعل الداعمين الغربيين يتوصلون لاستنتاج أنه ليس باستطاعة القوات الأوكرانية هزيمة نظريتها الروسية، وأنه من الأفضل استكشاف فرص السلام، والذي يعني في حده الأدنى إقرار كييف بخسارة جانب من أراضيها لصالح موسكو.
وفي الختام، يمكن القول إن الحسابات الخاطئة سوف تظل أحد الملامح الرئيسية للمعارك في العصر الحالي، والذي يشهد فيه تصاعداً متزايداً في وتيرة التنافس والصراع بين القوى الكبرى. صحيح أنه قد لا يمكن تفادي الحسابات الخاطئة تماماً، فإنه من المؤكد أن العمل على تصحيح الأخطاء، وتبني تقديرات واقعية للأوضاع في ساحة المعركة، وتحديد أهداف واقعية قابلة للتحقيق بموارد معقولة هو المفتاح لتحقيق النصر.
د. شادي عبدالوهاب أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني